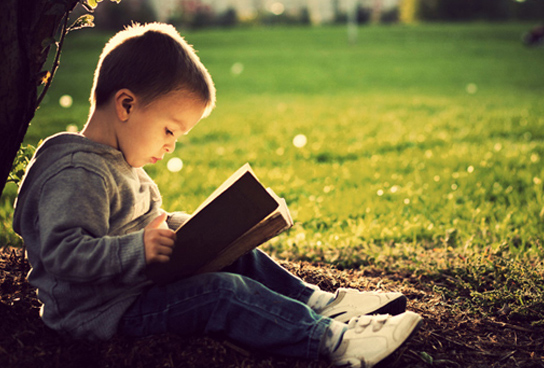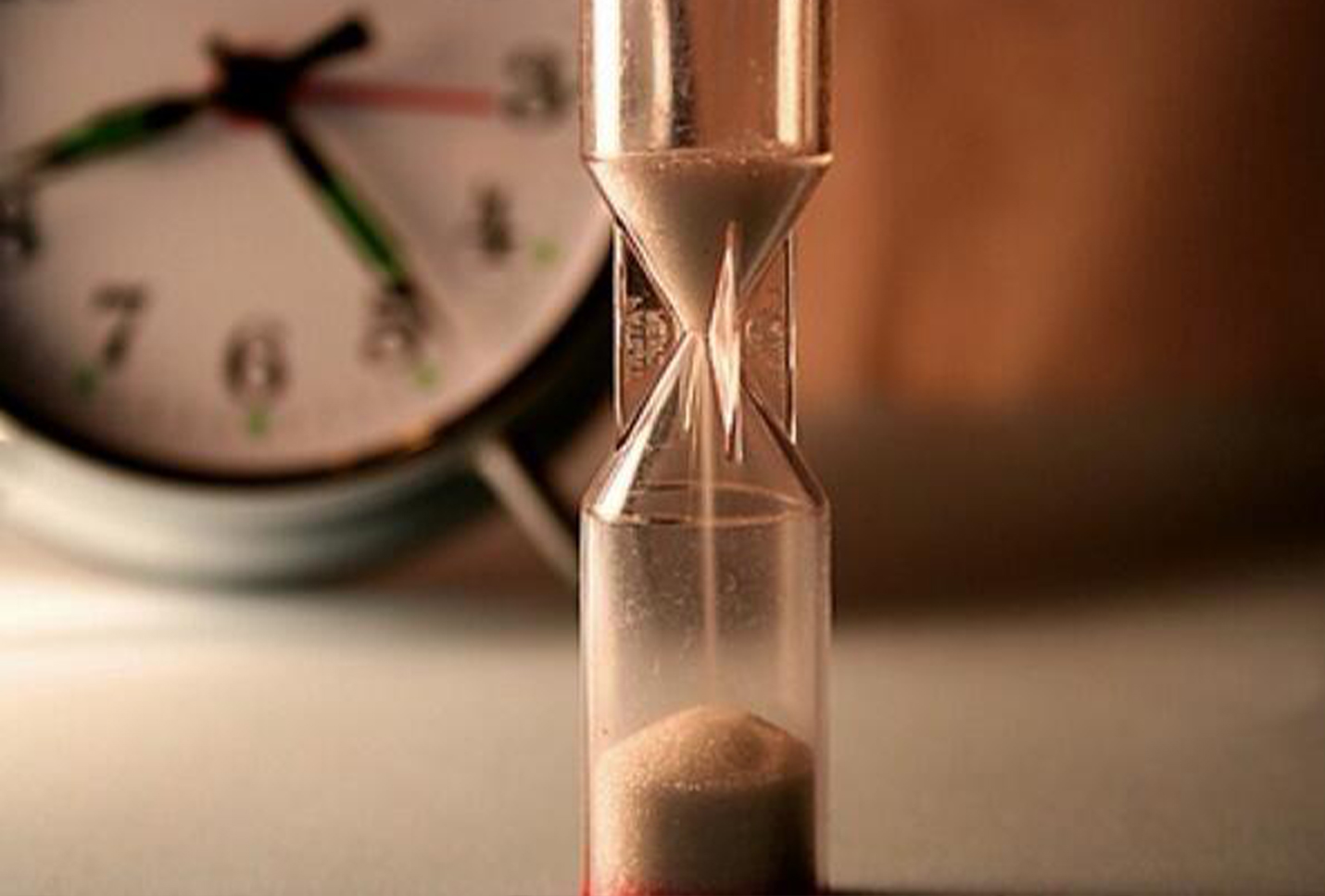سورة الأنبياء: العمل الصالح - رحمة النبي الكريم

- تدبر القرآن الكريم
- 2025-09-13
سورة الأنبياء: العمل الصالح - رحمة النبي الكريم
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربّ العالمين، إخوتي الكرام نُحييكم في هذا اللقاء الطيِّب من سلسلة حلقات نوافذ دينية، والتي نتناول الحديث فيها عن أنوار وتأمُّلات السور القرآنية، وصلنا لنهايات سورة الأنبياء، تعالوا بنا مستمعينا لأطايب وأنوار هذه السورة الجميلة. |
مقدمة:
| إخوتي الكرام: من نافذة هذا اليوم نفتح قلوبنا على خواتيم سورة الأنبياء، حيث تلتقي صور المشهد الكوني العظيم، بوعد الله لعباده الصالحين، وبإعلان الرسالة المُحمدية كرحمةٍ مهداةٍ للعالمين، إنها آياتٌ تُرسِّخ اليقين، وتُشعِل في القلب بصائر الرجاء، وتُعلِّمنا أنَّ المستقبل للعدل وللورثة الصالحين. |
| مستمعينا نكمل هذه المَشاهد والحديث عن جلالها وعظمتها، مع ضيفنا فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عضو رابطة علماء الشام، المدير والمشرف العام على الموقع الرسمي للدكتور محمد راتب النابلسي. |
| حيّاكم الله دكتور وأهلا ومرحباً بكم. |
الدكتور بلال نور الدين:
| حيّاكم الله. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| توقفت دكتور بلال في الحلقة السابقة، عند الحديث عن آية التوحيد والإيمان، والرسالة الواحدة لجميع الشرائع، وهي قوله تعالى: |
إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(92)(سورة الأنبياء)
| تحدَّثنا عن أنوار ما بعدها، وعن وعيد الله، وأننا راجعون إليه، نتحدَّث الآن عن الآية الرابعة والتسعين عن العمل الصالح، ما دلالة ذِكر العمل الصالح بعد كل هذا الوعيد، وهو لا يضيع عند الله، كيف تُرسِّخ هذه الآية قاعدة العدل الإلهي؟ وأنَّ الدين واحد في أصله، ولو تعمقنا قليلاً في السؤال، لتربِط لنا بين هذه الآية وبين بداية السورة، حيث كانت تتحدَّث عن الحساب، تفضَّل بارك الله بكم. |
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. |
| الآية الرابعة والتسعون من سورة الأنبياء، وهي قوله تعالى: |
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ(94)(سورة الأنبياء)
| وهذه الآية كما تفضَّلتم، تُبيِّن العدل الإلهي. |
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ(8)(سورة الزلزلة)
| واشترطت الآية شرطين اثنين: الأول العمل الصالح، والثاني الإيمان، لأنَّ هناك من يعمل لكن عمله ليس مبنياً على إيمانه بالله تعالى، فإذا تحقَّق الإيمان مع العمل، فالجواب: (فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) أي لن يجحَد الله له عمله، وإنما سيُثيبه عليه، لأنَّ الله تعالى من أسمائه الشكور، والشكور جلَّ جلاله يشكر للإنسان عمله، نحن اليوم إذا قدَّمنا عملاً لإنسانٍ رحيمٍ حكيم، فإننا نُدرِك أنه لا بُدَّ أن يُثيب على هذا العمل، فمن باب أَولى أنَّ الله تعالى جلَّ جلاله، يشكر للناس أعمالهم، شكره لأعمالهم يأتي على صيَغٍ مختلفة، يلقي في قلبه السكينة، يحفظ له أهله، يحفظ له أولاده، يُثيبه في الآخرة الثواب الأعظم، الثواب يكون في الدنيا سكينةً ورزقاً وخيراً، ويكون غالباً من جنس العمل، فإذا أنفق في سبيل الله أنفق الله عليه: |
{ قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: يا ابْنَ آدَمَ أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وقالَ يَمِينُ اللهِ مَلأَى، وقالَ ابنُ نُمَيْرٍ مَلآنُ، سَحّاءُ لا يَغِيضُها شيءٌ اللَّيْلَ والنَّهارَ }
(أخرجه البخاري ومسلم)
هذه الآية قانون (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً):
| وإذا ربّى أولاده كانوا له بارّين في مستقبل الأيام، وهكذا، ثم في الآخرة هو الثواب الأعظم، وهو المُعوَّل عليه (فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) فلا يمكن أن يُكفَر سعيه (وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) الإنسان دائماً إذا أقرض مالاً يقول له اكتُب لي ورقةً، فاكتبوه، كتابة تتناسب مع حاجة الإنسان في داخله، يُحب أن يكتُب حتى يُثبِت، فطمأنه الله تعالى: (وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) نكتب له هذا السعي في كتاب عمله، يوم يُبعَث فيُسرّ به عندما يراه، فهذه الآية كأنها قانون، في القرآن لمّا نقرأ: فمن، فلا |
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(97)(سورة النحل)
| مثلاً: |
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ(124)(سورة طه)
| هذه سُنَّةٌ من سُنَن الله، في العُرف الحديث قانون، هُنا أيضاً قانون، كل من يعمل عملاً صالحاً، يصلُح للعرض على الله، قائماً على إيمانه بالله، فإنَّ الله عزَّ وجل لن يُضيَّع عمله، وسيكتبه له حتى يجده يوم القيامة أمامه فيُسرَّ به. |
| وكما تفضَّلتم هذه الآية لو رُبِطَت ببداية السورة، فإنَّ الله في مَطلَع سورة الأنبياء قال: |
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ(1)(سورة الأنبياء)
| الحساب قريب، يراه الناس بعيداً لأنهم مغترون بالدنيا، يغفلون عن حقيقة هذا الأمر، لكنه قريبٌ جداً، فلمّا بدأت السورة (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) جاءت هُنا في الآية الرابعة والتسعين: (فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ). |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم يا دكتور، إذاً هذه الآيات وهي تتحدث عن هذه الأهوال، وتتحدث عن العمل الصالح، تتحدث عن وحدة الأُمة، يأتي بعدها الحديث عن أهوال يوم القيامة يا دكتور، تتحدث عن: |
حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ(96)(سورة الأنبياء)
| تتحدث عن: |
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ(97)(سورة الأنبياء)
| بعد ذلك يأتي الحديث عن تُبدّلٍ لوجه الأرض عند يوم القيامة، بدأت بالحديث له بمُمَهِداتٍ لاقتراب الوعد الحق، الحديث عن علامة ظهور يأجوج ومأجوج، ثم انتقلت الآيات للحديث عن طي السماء، السؤال: ما البُعد الإيماني الذي تولِّده استحضار سورة طي السماء، والحديث كان قبل هذا المشهد وهذه المشاهد الجميلة والبيانية، في تصوير هذه الأهوال يوم القيامة، تفضل. |
الدكتور بلال نور الدين:
| يقول تعالى: |
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ(104)(سورة الأنبياء)
النظام الكوني البديع بحيث كل ما في الكون مربوطٌ ببعضه:
| كيف تطوى الصحيفة على ما فيها، هذه الآية تُصوُّر مشهداً من مشاهد يوم القيامة، واقتراب الوعد الحقّ، فتتغير النُظُم الكونية التي كان عليها الكون، والقرآن الكريم كثيراً ما يتحدث عن تغيُّر النظام الكوني: |
إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ(1)(سورة الانفطار)
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ(1)(سورة الانشقاق)
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ(1)(سورة التكوير)
| هذا النظام الكوني البديع، بحيث كل ما في الكون مربوطٌ ببعضه: |
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ النظام الكوني وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(33)(سورة الأنبياء)
| لا يمكن أن يختل شيءٌ فيه في حياتنا، الشمس تطلُع كل يومٍ في وقتٍ مُحدَّد، يمكن أن نعرف من الآن متى تطلع الشمس عام 2050 في اليوم الفلاني في الساعة كذا تماماً في المنطقة الفلانية، هذا نظامٌ كونيٌ بديع، نظَّم الله تعالى به الكون، ليدل الناس به عليه، ليتفكَّر الناس بالكون فيستدلون من النظام على المُنظِّم، ومن الكون على المكوِّن جلَّ جلاله، هذا النظام البديع كما أنه كان مجالاً لاستدلال الناس على وجود الله، من خلال انتظامه ودقّته وبديع خلق الله به، سيكون يوماً دليلاً على بعث الناس للحساب وانتهاء مدة الامتحان، فنحن أمام هولٍ عظيم كما يتحدث القرآن عن اختلال النظام الكوني، شيءٌ يبعَث في النفس الرهبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: |
{ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِها، فإذا رَآها النَّاسُ آمَنَ مَن عليها، فَذاكَ حِينَ: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} [الأنعام: 158] }
(صحيح البخاري)
خسوف القمر آيةٌ كونية:
| الناس في موقفٍ مهيب إذاً، هذا اختلال، نحن قبل أيامٍ كان هناك خسوفٌ للقمر، نظرنا إلى آيةٍ كونية، لجأنا إلى المساجد، صلّينا، دعونا الله، ليس هناك اختلالٌ بمعنى الاختلال، وإنما ظاهرة غير معهودة، أن تأتي الأرض في وجه الشمس، فتُغطي وجه القمر، القمر الأحمر الدموي، هي اختلافٌ بسيط فقط وشعرّنا بهذه الرهبة في صدورنا، وشعرّنا بعظمة الله عزَّ وجل أكثر وأكثر، فكيف والكون كله يختل نظامه، الشمس من مغربها تُكوَّر، والسماء تنشق، وهنا: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ) السماء بكل ما فيها، الشمس التي في السماء تكبُر أرضنا بمليون وثلاثمئة ألف مرة، وتبعُد عنّا مئةً وستةً وخمسين مليون كيلو متر، وجوفها يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض، هي تبعُد عنّا فقط ثماني دقائق ضوئية، فما بالنا بالمجرات التي تبعُد عنّا ملايين السنوات الضوئية، القمر يبعُد ثانية ضوئية واحدة أو أقل، ثلاثمئة ألف كيلو متر، وننظُر إليه ونقول: ربّي وربُّك الله، نُسبِّح الله. |
| الآن عندما نقرأ هذه الآية، يحدث هذا البُعد الإيماني في قلوبنا، نستحضر عظمة الله تعالى (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ) كل السماء بما فيها من كواكبٍ ومجراتٍ ونجوم (نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ) كيف الإنسان يُمسِك كتاباً وفيه صحائف يطويها بداخله (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ) جلَّ جلاله المُبدئ المُعيد (وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) فهُنا يستحضر الإنسان هذه السورة، وهي من التشبيه كما تفضَّلتم، إعجازٌ بياني، هي نوعٌ من أنواع التشبيه، لكن التشبيه الراقي من أعلى مستوى، هذه الكاف كاف التشبيه، فشبَّه السورة بشيءٍ أمامنا، السماء كلها ستطوى هكذا؟ نعم ستطوى (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) أي كما نقول اليوم طي الكتاب، الصحائف التي بداخله (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ). |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| ولكن بعد هذا الحديث يا دكتور، وبعد الحديث عن أهوال يوم القيامة، تنتقل بنا الآية مئة وخمسة للحديث عن الأرض ومن يرثها: |
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(105)(سورة الأنبياء)
| إذاً هذه الآية تتحدث عن الأرض الصالحة، تتحدث عن وعدٍ تكرر وهو وعدٌ تاريخي للأنبياء وأتباعهم، ربط الله تعالى هذا الوعد بالقدس وبالبُعد العقدي، لفكرة الميراث الشرعي للأرض، كيف نفهم هذه الآية في واقع الأُمة المُعاصر يا دكتور؟ |
الشيء الذي كتبه الله لا يستطيع أحدٌ أن يمحوه:
الدكتور بلال نور الدين:
| هذه الآية الكريمة تبعَث في النفس الأمل، وتُحيي في القلوب وعد الله الحقّ، الشيء الذي كتبه الله لا يمحوه عباد الله، ولا يمحوه الظالمون، ولا يمحوه الطُغاة، لا يستطيع أحدٌ أن يمحوه، لا يمحوه صهاينةٌ ولا غيرهم، ولا الغرب ولا الشرق، لأنَّ الله كتبه (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ) الزبور هو الكتاب، الكُتُب التي أُنزِلت على الرسُل بشكلٍ عام، ويطلَق على الكتاب الذي أُنزِل على داوود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. |
| (مِن بَعْدِ الذِّكْرِ) قال العلماء: الذِكر هُنا اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) إذا عندما يقول الله تعالى: (يَرِثُهَا) إذاً مرجعها إليهم، قد تذهب إلى غيرهم لكنها ستعود إليهم، لأنَّ الله كتب ذلك (فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ). |
الغرب بنى إنساناً صالحاً لبلده والإسلام يريد عبداً صالحاً أولاً ثم مُصلحاً:
| إذاً الآية تُلقي الكرة في ملعبنا نحن المسلمين، هل نحن صالحون لعمارة الأرض؟ هل نحن صالحون للعمل بطاعة الله عزَّ وجل؟ نحن أُمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأرض أرضنا، وهذا وعد الله، ومصيرها إلينا، هذا معنى (يَرِثُهَا) إذاً ستعود، لكن هل نحن عبادٌ صالحون؟ |
| الغرب بنى إنساناً صالحاً يصلُح لبلده ولأرضه، فهو لا يُلقي شيئاً من نافذة السيارة أي القمامة، يتوقف عند إشارة المرور لا يتجاوزها، يحترم الخط الذي وضِع هُنا تقف السيارة، يدفع الضرائب الموكل بها وربما يحتقر من لم يدفعها، فيُحترَم لأنه يدفعها، هذا دافع الضرائب، يراها في بلاده عنايةً بالحدائق، وإنفاقاً على الأرصفة والشوارع، والصحة والتعليم وغير ذلك، فأصبح صالحاً لبلده، لكن الإسلام قال أنا لا أُريد صالحاً لعمارة بلده، أُريد عبداً صالحاً أولاً ثم مُصلحاً، لكن عبد أن يتحقَّق من عبوديته لله. |
| لذلك قال تعالى هُنا: (عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) فالعبد الصالح صالحٌ أينما كان، أمّا أنه يحترم بلده وقوانينها، ثم تُباد شعوبٌ بأكملها ولا علاقة له بها؟! هذا مواطنٌ صالح، نحن نريد العبد الصالح الذي يتحقَّق من عبوديته لله، يُصلِح في أرضه، ثم يكون مُصلحاً لمَن حوله، فاشترط القرآن الكريم هذا الشرط، وهو أن يكونوا عباداً أولاً، وأن يكونوا صالحين ثانياً، أن يتحقَّقوا من عبوديتهم ومن صلاحهم، ومن معاني الصلاح أن يصلحوا لعمارة هذه الأرض، وأن يصلحوا لإدارتها، فالصلاح نوعان: |
| صلاحٌ معنوي: مبني على معرفة الله وعلى العمل لجنَّته والبُعد عن ناره، على أخلاقٍ قويمة مستقيمة. |
| وصلاحٌ مادي: يعني أن يتعلم الإنسان العلوم التي تؤهله لعمارة الأرض وقيادتها، فهذه الآية إذاً مُطمئنة وفي آنٍ معاً تجعل الكرة في ملعبنا، تُكلِّفُنا فهي طمأنةٌ وتكليف، طمأنةٌ بأنَّ وعد الله حق، فقد كتبه الله تعالى، وبأنَّ الأرض لنا إن شاء الله، وطمأنةٌ لأهلنا في الأرض المحتلة بأنَّ الأرض عائدةٌ إلى أهلها، وأنَّ القدس ستعود إلى المسلمين، وأنَّ غزَّة ستبقى جزءاً من أرض الإسلام، طمأنة كاملة، وفي الوقت نفسه تُلقي علينا مسؤولية أن نتحقَّق من العبودية لله تعالى، وأن نكون صالحين في طاعتنا لربنا وفي إدارة أرضنا التي يورثُها الله تعالى لنا عندما يشاء. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نسأل الله الصلاح والإصلاح يا رب، وكذلك الآية يا دكتور التي تلتها: |
إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ(106)(سورة الأنبياء)
| هل هذا يُدلِّل أنه هُنا استخدم لفظ العبودية بدلاً من أن يقول: إِنَّ فِي هذا لبلاغاً لقومٍ مُتَّقين مثلاً أو خاشعين، فدلَّل هُنا أيضاً على معنى العبودية. |
معنى العبودية:
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم الآيات تُركِّز على هذه القضية صحيح، تُركِّز على معنى العبودية عندما نقول أرضٌ مُعبَّدة يعني وطأتها الأقدام حتى أصبحت مُذلَّلة، فالعبودية هي أن أُخضع حياتي لمنهج الله تعالى، بالمفهوم الواسع (لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) يعني جعلوا حياتهم وفق منهج الله تعالى، العمل التجاري، العلاقة مع الأولاد، العلاقة مع الزوجة، حتى اللعب عندما يلعب الشباب يكونوا في عبادة إن كانوا مؤمنين، يجعلون اللُعبة وفق منهج الله، في طاعة الله، ولا تشغلهم عن فريضة فأصبحت عبادة، المفهوم العام للعبادة أن أجعل حياتي وفق منهج الله، فهذا الكتاب الذي كتبه الله تعالى، أنَّ الأرض ستكون لعباده الصالحين، أيضاً هذا بلاغ يصل إلى العباد الذين تحقَّقوا من عبوديتهم لله تعالى. |
المحاورة هناء المجالي:
| إذاً هذه من عتبات العبودية يا دكتور، بارك الله بكم ونفع بكم. |
| ومن هذه الصور ليوم القيامة الوعد والوعيد، يأتي الحديث عن الرحمة المُهداة، صلوات ربّي وسلامه عليه، كيف تجلَّت الرحمة في الهجرة، في الجهاد، في الدعوة؟ وهُنا كيف نُفرِّق بين رحمة الرسالة وحزمها أمام الباطل يا دكتور؟ تفضل. |
ميراث الأرض ووصولها لأهلها بعد غيابٍ لن يكون بغير معركة:
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم، الحقيقة هذه الآية في هذا الموضِع تلفِت النظر، لأنَّ الحديث هُنا كأنه عن معركة، لأنَّ ميراث الأرض ووصولها لأهلها بعد غياب، لن يكون بغير معركة، هكذا هي سُنَّة الله تعالى، يعني لن يكون هناك شيءٌ من السماء مُعجزة تُزيلهم، لا نحن الآن في عالَم الشهادة نحتاج إلى معركة، سيكون هناك معركةٌ بين الحقِّ والباطل تنتهي بإزالة الباطل، فأن تأتي الرحمة في هذا الموضِع، لها دلالات عظيمة وعميقة، أول دلالةٍ في الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم أُرسل رحمةً للعالمين، لم يقُل لقومك، ولم يقُل لبني جلدتك، ولا لعشيرتك، ولا لقُريش، ولا للمؤمنين، قال: لِّلْعَالَمِينَ، يعني كل العوالم بما فيها سواءً كانت إنساً أو جِنّاً، أو حيواناً أو نباتاً، كل العوالم أُرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حصرٌ وقصر: |
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ(107)(سورة الأنبياء)
| و (مَا) النفي مع (إِلَّا) يُفيد الحصر والقصر، فأنت يا محمد، صلى الله على نبينا محمد، لم تُرسل إلا لهدفٍ واحدٍ وهو الرحمة، فكل ما حصل في جهادك، وفي دعوتك، وفي قتالك لأعدائك حتى، كان رحمةً وللعالمين، فالبُعد المهم في هذه الآية هو كما تفضَّلتم هُنا، بين رحمة الرسالة وحزمِها أمام الباطل، قال الشاعر: |
فَقَسا لِتَزدَجِروا وَمَن يَكُ حازِماً فَليَقسُ أَحياناً وَحيناً يَرحَمُ{ أبو تمام }
رحمة الرسالة وحزمِها أمام الباطل:
| اليوم عندما أجد أباً يُعاقب ابنه وبشدَّة، أو قد أصفها بقسوةٍ أحياناً، فأتحرَّى لماذا يُعاقبه؟ فأجد أنَّ الابن قد أخطأ خطأً جسيماً، وتكلم كلاماً فاحشاً، ولو أنَّ الأب تركه دون حزمٍ، فإنه ربما يستحق النار والعياذ بالله إن استمرَّ على ما هو فيه، فهُنا الأب تصرَّف بتصرُّفٍ ظاهرهُ القسوة وحقيقته الرحمة. |
| أنا عندما أدخُل إلى غرفة عمليات، وأجد الطبيب قد فتح بطن المريض، وأخرج بعض أجهزته، وبدأ بمبضعه يشرط الجلد واللحم، وأحياناً ينشُر العظم، منظرٌ مُخيف، وقد يقول إنسانٌ جاهل: ما أقسى الطبيب، وفي الحقيقة الطبيب رحيم، يقوم بعملٍ رحيمٍ جداً، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بأمته، حتى وهو يُحارب أعداءُه، لأنه كان يريد أن ينتشلهم من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعِلم، ومن ذلّ الشرك إلى عزّ التوحيد، فالرحمة رافقته حتى وهو في أرض المعركة، فنحن لسنا دُعاة قتلٍ ولا دُعاة دم، وحتى الجهاد، والجهاد هو باختصارٍ شديد، جهاد الدفع معروف نحن ندافع عن أنفسنا ضد أعدائنا، لكن جهاد الطلَب هو قمة الرحمة. |
| أنا معي بضاعة عظيمة النفع، وسعرها معتدل، أُريد أن أدخُل السوق لأبيعها، وأنت تملأ السوق ببضائعٍ سيئةٍ وتبيعها بأسعارٍ مرتفعة، وأنا أُريد أن أدخل لأعرِض بضاعتي رحمةً بالناس، رحمةً بالزبائن، فإن سمحت لي أن أدخُل، عرضت بضاعتي وليشتري الناس بضاعتي أو بضاعتك، هُم أدرى بما يُصلحهم، وأنا أُدرِك أنَّ البضاعة التي عندي سُتباع، وأنَّ البضاعة التي عندك لن تُباع إلا للجاهلين، لكن لمّا منعتني من الدخول! لا، يجب أن أدخُل، هذا هو الجهاد في الإسلام، سأدخل وأعرِض ما عندي. |
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(256)(سورة البقرة)
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا(29)(سورة الكهف)
الجهاد رحمةٌ عظيمةٌ للناس:
| لكن لا بُدَّ أن أعرِض البضاعة على الناس، لماذا؟ لأنني أرحمهم، أُريد نجاتهم، لا أُريد أن تستعبدهم، وأن تمنعهم من معرفة أنَّ هناك حقَّاً يمكن أن يُتَّبع، وأن ينجو بصاحبه في الدنيا والآخرة، فمن هذا المُنطلَق الجهاد رحمة، رحمةٌ عظيمةٌ للناس، لنشر الخير، وإيصال الخير، وهذا ما كان في كل حروب المسلمين، كانت الرحمة ظاهرةً، ليس كما يفعل اليوم أعداؤنا، يقصفون المُنشآت، ويقتلون النساء والأطفال، ويدمِّرون المُنشآت دمار في دمار، لا، كله مبني على الرحمة، فمن هُنا جاءت آية: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) بعد قوله تعالى: (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ). |
المحاورة هناء المجالي:
| بارك الله بكم، إذاً هُنا يظهَر المقصد الأعظم للرسالة، وهو الرحمة الشاملة بالناس جميعاً، وهذا هو الأسلوب، وأنت ذكرت الجهاد وذكرت الدعوة، إذاً الأسلوب يجب أن يمتاز بدايةً بالرحمة، وهو أسلوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المُهداة، بارك الله بكم. |
| نأتي الآن يا دكتور إلى البلاغ المُبين، والموقف الواضِح وهو ما نصَّت عليه الآية مئة وتسعة: |
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ(109)(سورة الأنبياء)
| إذاً صرامةٌ في إعلان الحقّ، كيف نستفيد من هذا الموقف في الدعوة اليوم؟ كيف يواجه المسلم التكذيب بثباتٍ ووضوح؟ |
المُفاصلة بين الحقّ والباطل:
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم بارك الله بكم، قال تعالى: (فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ) أي أعلمتكم، والأذان الذي نسمعه كل يومٍ خمس مرات، هو إعلامٌ بدخول وقت الصلاة (فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ) الجميع، على أمرٍ مستوٍ بيني وبينكم، من المُفاصلة (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ) هل يأتي عذابكم قريباً أم بعيد؟ هذا عند الله ليس من شأني، فهذه الآية الكريمة فيها قضية المُفاصلة أولاً، المُفاصلة بين الحقّ والباطل، وفيها بيانٌ لمهمة الرُسل ومهمة الدُعاة من بعد الرُسل، ومهمتهم هي الإبلاغ. |
لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ(272)(سورة البقرة)
| فاليوم الداعية عندما يُبلِّغ رسالة ربّه، ينشر الحقّ، يُبيِّن للناس الجائز والحرام، الحقّ والباطل، الخير والشر، تنتهي مهمته هُنا، ما بعدها هذه عند الله تعالى وحده، هذا أولاً فيه رسالة راحة للدُعاة، نعم الداعية في قلبه رحمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ربّه: |
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا(6)(سورة الكهف)
| تكاد تُهلِك نفسك أسفاً أن لا يكونوا مؤمنين، فتأسف لحالهم هذا وضعٌ طبيعي، ضمن حدود، لكن أنا عندما أعلم أنَّ مهمتي هي أن أُبلِّغ، أنا لا أستطيع هداية الناس، لا أستطيع تبليغهم، وتوضيح طريق الحقّ لهم، أمّا هل يسلكوه أو لا يسلكوه، هذا أمرٌ آخر مردود إلى اختيارهم، وإلى توفيق الله تعالى لهم بعد اختيارهم، فمَن أراد طريق الهداية وفَّقه الله إليه. |
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ(17)(سورة محمد)
| ومن يزيغ عنه: |
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5)(سورة الصف)
التجديد المذموم في الدين:
| فيكون منه الاختيار، ومن الله تعالى هداية التوفيق، أو إضلاله لأنه أراد الضلال، فهذه الآية نصٌ في مهمة الرُسل ومهمة الدُعاة من بعدهم، وهي أنه المطلوب منّا: |
| أولاً: الدعوة إلى الله تعالى، إبلاغ الرسالة إلى الناس، هذا هو المطلوب منّي كداعية. |
| ثانياً: المُفاصلة (فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ) المُفاصلة بمعنى أنني عندما لا أجد قَبولاً من الناس، ما الذي يفعله اليوم بعض الدُعاة؟ يَرجعون إلى بضاعتهم، يعني أنا اليوم عرضت بضاعة على الناس، وأنا واثقٌ من صلاحيتها، الآن رفضها الناس، هل أرجع إلى البضاعة؟ هذا ما يفعله بعض الدُعاة اليوم، قال تعالى: |
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(50)(سورة القصص)
| يا رب لا يستجيبوا ماذا أفعل؟ راجع النصوص الشرعية، أوجد لهم بعض الحلول، خفِّف عنهم بعض التكاليف، أَوِّل لهم بعض النصوص، هذا ما يفعله اليوم بعض دُعاة التجديد، التجديد المذموم، يفعلونه، يُراجعون البضاعة، يقولون مثلاً: الخمر ليس مُحرَّماً بل هو اجتناب، مكروه والعياذ بالله، يعبثون بدين الله، لأنَّ الناس لم يستجيبوا يا أخي، العصر قد تغيَّر، نريد أن نُخفِّف عنهم، أنت هذا ليس مطلوباً منك (فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ) أنا يوجد مُفاصلة بيني وبينكم، فإن استجبت فقد استجبت، وإلا فأنت تتبِع هوى نفسك، أنا ما دام دعوت إلى الله بما جاء به الله، ووفق الأسلوب الشرعي الصحيح، تمَّت مهمتي ولا يمكن بحالٍ أن أُراجع ما عندي، لأنَّ ما عندي هو الحقّ، ليس لأنني أنا، بل لأنه حقٌّ من الله تعالى، فأنا أُبلِّغك، وأنت إن شئت اتَّبِع أو لا تتبِع، وإن لم تتبِع: (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ) حسابه عند الله، فنحن دُعاة ولسنا قُضاة، أنا لن أُقاضيك، أنا ليس شأني في مقاضاتك. |
| فهذه الآية أعطت ثلاثة أمور للداعية. |
| الأمر الأول: عليك البلاغ وليس عليك الهداية. |
| الثاني: لا تعُد إلى ما عندك من الحقّ فتُبدِّل وتُغيِّر فيه، لأنَّ هذا شيءٌ سيءٌ جداً. |
| الأمر الأخير: أنت داعية ولست قاضٍ الحساب عند الله. |
المحاورة هناء المجالي:
| بارك الله بكم يا دكتور، هذه تأويلاتٌ جميلةٌ جداً، هذه تأويلاتٌ تدعو إلى الوسطية، هذه تأويلاتٌ تدعو إلى الإحسان حتى وإلى تزكية النفس، بارك الله بكم يا دكتور. |
| وأنت هُنا تتحدث يا دكتور عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أمام الغيب، اعترافه بعدم علمه للغيب (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ)، كيف تُعلِّمنا هذه الآية التوازن بين اليقين بالوعد والجهل بوقت تحقيقه؟ |
المؤمن يتلقى خبر الله تعالى وكأنه يراه بعينه:
الدكتور بلال نور الدين:
| الحقيقة أننا نعيش في عالَمٍ هو عالَم الشهادة، وهو كل ما نشاهده بعيننا، أو نسمعه بآذاننا، أو نتكلم بأفواهنا، هذا عالَم الشهادة، وهناك عالَمٌ آخر هو عالَم الغيب، ونحن لا ندري من هذا العالَم إلا بقدر ما يُعلمنا الله تعالى منه، وهو جلَّ جلاله: |
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(18)(سورة التغابن)
| فالآن في ختام الآية: (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ) كما تفضَّلتم ما توعدون هذا يقين، يقينٌ إخباري، والمؤمن يتلقى خبر الله تعالى وكأنه يراه بعينه، ما عنده فرقٌ أو بَون بين الخبر والمشاهدة، إذا كنت أنا الآن أقول هذه محفظةٌ أمامي، هذه مشاهدة، حسّ، محسوس، إذا جاء والدي وهو عندي صادقٌ مئة بالمئة وقال لي: خلف هذا الجدار يوجد محفظة، ليس عندي شكّ ولا لثانية، ولا أتردَّد في أنه يوجد محفظة، فالخبر عندي أصبح كالمشاهدة، لماذا؟ لأنَّ الذي أبلغني هو أبي وأبي لا يكذِب، الآن في عالَمِنا اليوم هناك شيءٌ أُشاهده فأنا مؤمنٌ به، حدث حادث سيارة أمامي فأنا مؤمنٌ به حدث، هذا حس، عندما يغيب شيءٌ عني ويُخبرني به عدلٌ ثقة فأنا أثق به كأنني أراه، الآن المؤمن يتلقى خبر الله ووعد الله تعالى وكأنه يراه، لذلك قال تعالى مخاطباً نبيه: |
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ(1)(سورة الفيل)
| هو لم يرَ لأنه ولد عام الفيل، لكنه تلقى خبر الله تعالى وكأنه يراه بعينه. |
| قال بعض السلف: لقدر رأيت الجنَّة والنار عياناً، قالوا: انظر فيما تقول!! فوالله ما أحدٌ رأى الجنَّة والنار عياناً، قال: لقدر رأيتهما بعينَي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينَي رسول الله أصدق عندي من رؤيتي لهما بعيني، لأنَّ بصري قد يزيغ ويطغى أمّا بصره: |
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ(17)(سورة النجم)
| هذا هو الإيمان، هذا هو اليقين، لكن عندما لا يُخبرني الغيب عن شيءٍ مُعيَّن فأنا أُسلِّم به، هذه الآية حقَّقت هذا التوازن (وَإِنْ أَدْرِي) أنا لا أعلم (أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ) لكنه حاصلٌ حتماً. |
| اليوم أهلنا في فلسطين، أهلنا في غزَّة، لا أدري إذا كان النصر غداً أو بعد غد، أو بعد سنة، أو بعد عشر سنوات، أنا لا أدري، حكمة الله تعالى تقتضي أن يُؤخِّر أحياناً، حتى تتسع دائرة المُمتحنين، حتى يتخذ من عباده شهداء، حتى يُعلي قَدر من يُعلي، ويكشف نفاق من يكشف، لا بُدَّ أن يطول الامتحان، لكن متى ينتهي؟ لا أدري، لكنني مؤمنٌ بالوعد، هذا هو التوازن بين اليقين بموعود الله تعالى، والتسليم عندما يتأخر هذا الموعود لحكمةٍ يعلمها الواعد. |
المحاورة هناء المجالي:
| لا إله إلا هو، صدقاً يا دكتور نقف صامتين طويلاً أمام هذه التجليات العظيمة، وهذه التفسيرات الجليلة لفضيلتكم، فتح الله عليكم في هذه التفسيرات القيِّمة، وهذه التفسيرات والأنوار واللطائف، بارك الله بكم يا دكتور. |
| وقبل الحديث عن ختام الآيات، نتحدث يا دكتور عن الآية التي قبلها، عن الفِتنة والمَتاع، ما المقصود بالفِتنة والمَتاع في آخر هذه السورة الجليلة؟ |
معنى الفِتنة والمَتاع:
الدكتور بلال نور الدين:
| الفِتنة والمَتاع: |
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ(111)(سورة الأنبياء)
| كما في الآية قبل الأخيرة من سورة الأنبياء، الفِتنة هي الامتحان في الأصل، يُقال: فتنت الذهب، أي عرَّضته للنار حتى أُميِّز بين رديئه وجيّده، فربُّنا عزَّ وجل عندما يُمهل بالعذاب، يُؤخِّره، يُمهل بالوعد الذي تحدثنا عنه قبل قليل ويُؤخِّره ربما يكون هذا فِتنة، اختبارٌ لكم واستدراج، وتمتيعٌ لكم. |
| كلمة فِتنة في الأصل هي الاختبار (لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ) يختبركم الله بطول الأمد، وهذا الاختبار لا يكون فقط للكافرين وللأعداء، يكون للمؤمنين أيضاً، هناك من يسقط على الطريق نسأل الله السلامة والثبات (لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ) لكنه قد يكون أيضاً مُتعة، استدراج، كل ما يأتي من الله تعالى بحسب العبد تكون طبيعته، تأديب الله تعالى لعباده بتأخير النصر، بتعجيل الفرج، بأي شيء يُجريه الله تعالى في الكون يكون بحسب الإنسان، فيكون لإنسانٍ رفعاً لدرجاته، ويكون لآخر تكفيراً لسيئاته، ويكون لثالث استدراجاً له، فمعالجة الله تعالى لعباده متنوعة، المصيبة نفسها تنزل فتكون للبعض رفعاً للدرجات ودفعاً إلى باب الله، دفعٌ ورفع، وتكون للبعض الآخر استدراجاً، قال تعالى: |
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ(44)(سورة الأنعام)
| وتكون لآخرين رَدعاً وقَصماً، يعني كطائرة انطلقت من بلدٍ إلى آخر وعلى متنها مئةُ راكب، هذه الطائرة لحكمةٍ بالغةٍ من الله، أصابها عَطَبٌ ووقعت ومات جميع ركابها، من الجهل أن يقول قائلٌ: عاقبهم الله، هذا جهل، في الطائرة رجُلٌ ذاهبٌ لطلب العِلم الشرعي في هذا البلد الذي يذهب إليه، مات على نيته وذهب شهيداً في سبيل الله، في الطائرة رجُلٌ خرج ليعمل ويكسب رزقاً يعود به إلى أهله، فهو في جهادٍ مادامت نيته طيبة وعمله عبادةٌ لله تعالى، في الطائرة رجُلٌ ذهب لأنه علِم أنَّ فلاناً في هذا البلد يريد أن يقتله يُدبِّر له مكيدةً، ذهب على نيته، في الطائرة رجُلٌ ذهب ليقوم بسياحةٍ من نوعٍ لا يرضي الله تعالى، ذهب والعياذ بالله وهو مُتلبِّسٌ بهذه المعصية العظيمة ومُقبِلٌ عليها، فكلٌ ذهب على نيته، هُنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ) فتنةٌ لمَن؟ يُختبَر فيُمتحَن، فينجح أو يخسر. |
| (وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) قد يكون هذا التأخير في الوعد وابتعاده مُتعة على حين، إلى وقتٍ الله أعلم به، يُمتِّعه الله تعالى ثم يضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فكل إنسانٍ على نيته فِتنةٌ ومَتاع. |
المحاورة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم على هذا الربط وهذا التصوُّر الجميل لتفسير هذه الآية الكريمة يا دكتور. |
| عندما نأتي إلى هذه النهايات يا دكتور وهنالك الآية التي قبلها: |
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ(110)(سورة الأنبياء)
| إذاً هذه النهايات أيضاً كان لها بدايات مشابهة في سورة الأنبياء عندما يقول الله تعالى: |
قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(4)(سورة الأنبياء)
| إذاً هُنا وحدة مواضيع، هُنا تناسقٌ في المواضيع، يأتوا كبيانٍ لعظمة الله سبحانه وتعالى في خَلقه، وخصوصاً في سورة الأنبياء، والتي تتحدث عن العصور السابقة والعصور اللاحقة فيما بعد، ولكن الختام يأتي بختامٍ جميلٍ لا يُشابههُ ختامٌ في أي سورة، وهو الاستعانة بالله والدعاء الختامي، كيف نستلهم من هذا الدعاء المواجهة للظلم والباطل اليوم؟ كيف ارتبط الدعاء برسالة القرآن في ختام هذه السورة الجليلة، والتي تتحدث عن أنبياءٍ وعن أقوامٍ تفضَّل. |
الدكتور بلال نور الدين:
| الحقيقة كما تفضَّلتم الآية الأخيرة وهي الثانية عشر بعد المئة، فيها شيءٌ يُسلّي عن الإنسان ويدخِل الطمأنينة إلى القلب، وفيها تسليمٌ لله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نقول من بعده داعين ربنا جلَّ جلاله: |
قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ(112)(سورة الأنبياء)
ربُّنا جلَّ جلاله لا يحكُم إلا بالحقّ:
| ربُّنا جلَّ جلاله لا يحكُم إلا بالحقّ، لو بدأنا بكلمةٍ كلمة من هذه الآية العظيمة: (قَالَ رَبِّ) دُعاء، أي "يا ربّي" حُذفت أداة النداء وفيها القُرب هُنا من الله تعالى قريبٌ جلَّ جلاله، وفيها معنى الربوبية، ما قال: يا الله، قال ربِّ، الربّ يُربّي عباده، نقول ربُّ الأسرة أي مُربّيها، القائم على شؤونها، ومن ربوبيته جلَّ جلاله أنه يفصل بين عباده بالحقّ، من ربوبيته أن يُطعمنا، نأكل ونشرب هذا من ربوبيته، يُمدُّنا بالهواء ربوبية، كل ما يأتي من الله ربوبية، يُعطينا الولد ربوبية، يُزوِّج الشاب ويزوِّج الفتاة ربوبية، ينزل الماء من السماء ربوبية، ينبُت الزرع ربوبية، فكله من تربية الأجساد، لكن هُنا تربية النفوس (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ) فربوبيته جلَّ جلاله تقتضي، أنه لا يمكن أن يترك عباده دون أن يفصل بينهم. |
| الأب في الأُسرة يُطعِم أولاده، يأتيهم باللباس، يأتيهم بالماء، بالطعام، بالشراب، وإلى أخره.. يُسجلهم في المدارس، لكن إذا كان جالساً واختصم ابناه أمامه، وقام كلٌ منهما ربما يضرب ويعتدي واحد على الآخر، والأب جالس يشاهد وكأنه يُتابع مشهداً على الشاشة، هل هذا الأب مُربّي؟! لا والله، كان ينبغي أن يتصرَّف، أن يحكُم بالحقّ، أن يقول للمُذنب تعال فيُعاقبه ويُؤدّبه، ولمَن أُسيء إليه أن يأخذ له حقَّه، هذه ربوبيته، وربُّنا جلَّ جلاله يحكُم بين عباده بالحق، لكن حكمته تقتضي أحياناً أن يُؤخِّر الفصل حتى يظهر ما في النفوس أكثر وأكثر، كما يفعل الأب أحياناً، ربما يكون يُشاهد عن بُعد أولاده هو سيحكُم بينهم بالحقّ، لكنه يتركهم إلى حين ليظهَر خُبث الخبيث ونظافة النظيف، فهُنا قال: (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ) افصل بيننا وبين قومنا الذين أصرّوا على الكُفر، بالقضاء بالحقّ فأنت الحقّ جلَّ جلالك، الله تعالى هو الحقّ، وحقَّ الشيءُ يحقُّ أي ثبتَ يثبُتُ: |
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ(82)(سورة يونس)
كل شيء ثابت وله هدف هو حقّ وكل شيء زائل وعابث فهو باطل:
| وبَطَل الشيء يبطلُ إذا كان زهوقاً، زائلاً، فكل شيء ثابت وله هدف هو حقّ، وكل شيء زائل وعابث ليس له هدف فهو باطل، أحياناً نبني جامعةً تدوم مئةُ عامٍ، فهي ثابتة ولها أهدافٌ عظيمة فهي من الحقّ، وإذا كان هناك بعض أيام العيد، عيد الفطر، ووضعنا سيرك لبعض الحركات البهلوانية، فإنه يُقام لثلاثة أيام، فهو شيءٌ عابثٌ لا هدف له وزائل، قماش يوضع ثم يُلَف ونذهب بالأعمدة وانتهى، كأنه لم يكن شيء، فالحقّ شيء والباطل شيءٌ آخر، فربُّنا عندما يَحكُم يَحكُم بالحقّ، وهو الشيء الثابت المستمر الهادف. |
| فهذه الآية الكريمة في ختام السورة، تُضفي على النفس راحةً ما بعدها راحة، لأنَّ الله هو الذي سيفصل بين عباده، أنت تقول وأنا أقول، وأنا ربما أقضي إلى الله تعالى، ولمّا يتضح لك أنني كنت على حقّ، وأنك كنت تُعاديني بباطل، طبعاً لم يتضح لك لأنَّ حُجُب الشهوات والمصالح تمنعك، لكن الأمور واضحة لكن أنت أعرضت عن ذلك، فيُريحني أنني أقول في النهاية: يا ربّ أنت تحكم بين عبادك، فاحكُم بيننا بالحقّ وأنت الحقّ جلَّ جلاله، فعندها أرتاح نفسياً لأنَّ الله هو الذي سيفصل، مثل إذا كان عندي مشكلة مع شخص ومضى لها عشر سنوات، ثم قيل لي القاضي فلان الفلاني هو الذي سيفصِل، فلان سيفصل؟ نعم فلان عادلٌ ورحيم، وأعرف عنه الكثير، وهو لا يحكُم إلا بالحقّ فأرتاح، تدخل إلى قلبي الراحة لأنَّ من سيحكُم يحكم بالحقّ، فنحن اليوم في معركتنا مع أعدائنا لمّا تنتهي السورة وتقول لنا: (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ) الله هو الذي سيفصل. |
| أعرابيٌ من الأعراب قيل له: "إنك ستقدُم على الله ألا تخاف؟ قال: ومن الذي سيُحاسِب؟ قالوا: الله، قال: نجوت، قالوا: ماذا تقول؟ قال: إن الكريم إذا حاسب تفضَّل". |
| وبنفس الوقت عندما أعلم أنَّ المنتقم من الظالمين، الذين يقتلون الناس ويُجرمون بحقِّهم، إذا حاسب سيُعاقِب أيضاً أرتاح، بنفس راحة المؤمن بأنَّ من سيُحاسبه سيتفضَّل عليه، يكون عذاب الكافر بأنَّ الذي سيُحاسبه لن يتركه ولن يُفلِت من العذاب. |
وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ(102)(سورة هود)
الرحيم رحمته ظاهرة لكن الرحمن قد ينتقم:
| (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ) تعود إلى ربّ الربوبية هُنا بالرحمة، والرحمن غير الرحيم، الرحيم رحمته ظاهرة: |
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا(43)(سورة الأحزاب)
| لكن الرحمن قد ينتقم، قال تعالى على لسان إبراهيم: |
يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا(45)(سورة مريم)
| فالرحمن تقتضي رحمته أن يُعذِّب البُغاة والظالمين ليُحقَّ الحقَّ بكلماته، قال: (وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ) نستعين به جلَّ جلاله على ما تصفون به، وتقولونه من الكفر والتكذيب، وعلى ما تصفوننا به من الإرهاب والهمجية، وأننا شعبٌ منبوذ وأنتم شعب الله المختار (وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ) نستعين به على كل ما تصفون به ربكم وما تصفوننا به، وعلى ما تقولونه من كُفرٍ، والتكذيب والجحود، هذه الآية تُلقي في النفس راحةٌ عظيمة لأنَّ الله تعالى هو ربُّنا، وهو رحمنٌ، وهو مُستعانٌ وهو يحكُم بالحقِّ جلَّ جلاله. |
المحاورة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم يا دكتور، بهذه التجليات والطمأنينة نطوي صفحات سورة الأنبياء، بين مشهدٍ كونيٍ مَهيب، ووعدٍ مؤكَّدٍ للصالحين، ورسالة محمدية تُظلِّل الدنيا بالرحمة، ودعاءٌ نبويٌ يرتفع إلى السماء (رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ) إنها خواتيم تُعلِّمنا أنَّ العدل منتهى الطريق، وأنَّ الرحمة هي الرسالة، وأنَّ المصير كله إلى الله الذي لا يظلم مثقال ذرة. |
| بارك الله بكم يا دكتور، ونفع بكم، وطيَّب الله أنفاسكم، شكراً جزيلاً الدكتور بلال نور الدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن، شكراً جزيلاً. |
الدكتور بلال نور الدين:
| عفواً، بارك الله بكم، شكراً لهذه الاستضافة الكريمة. |