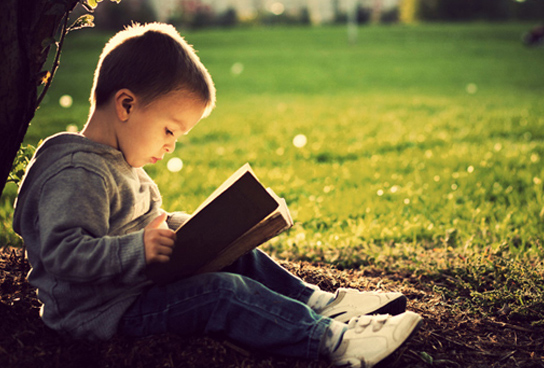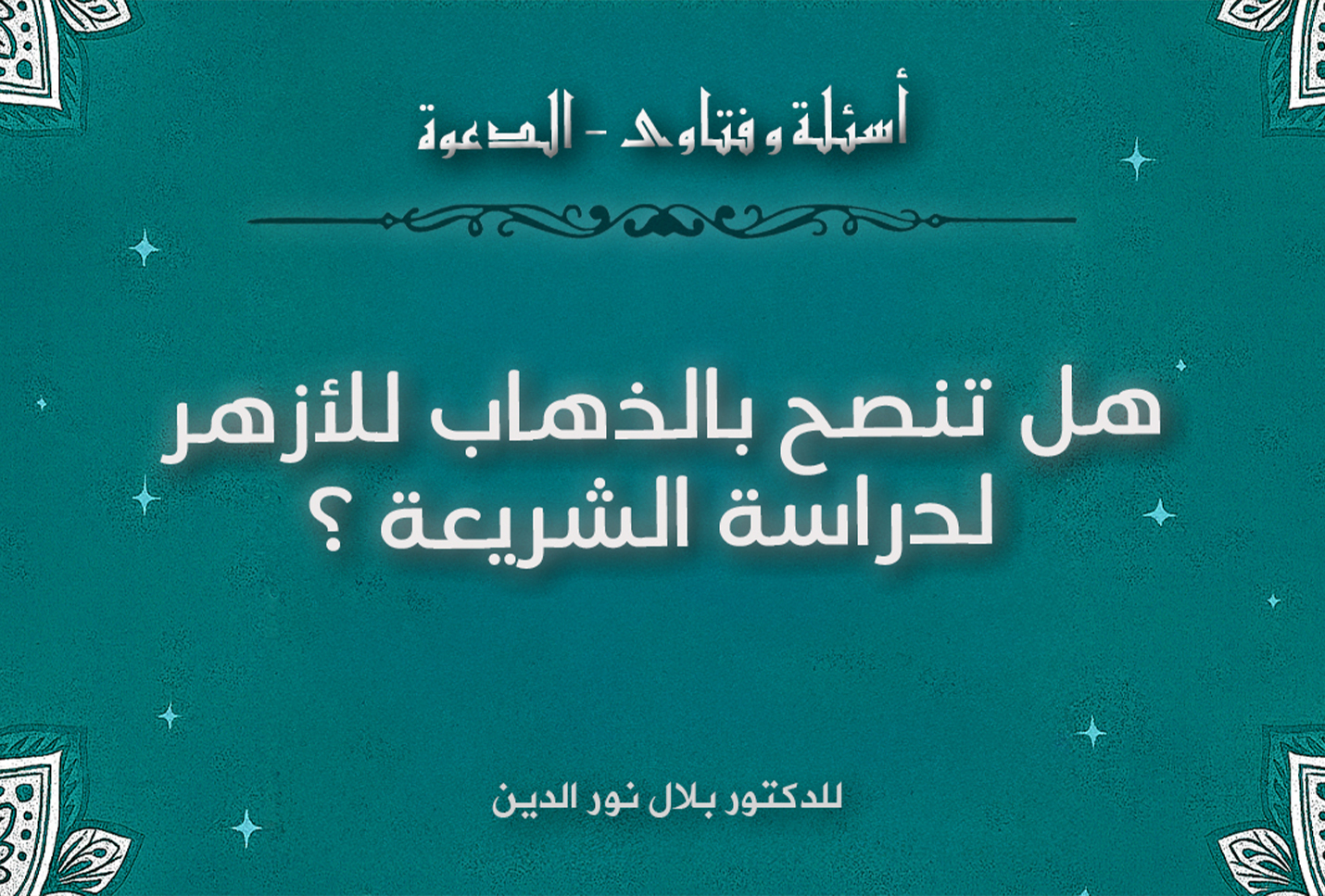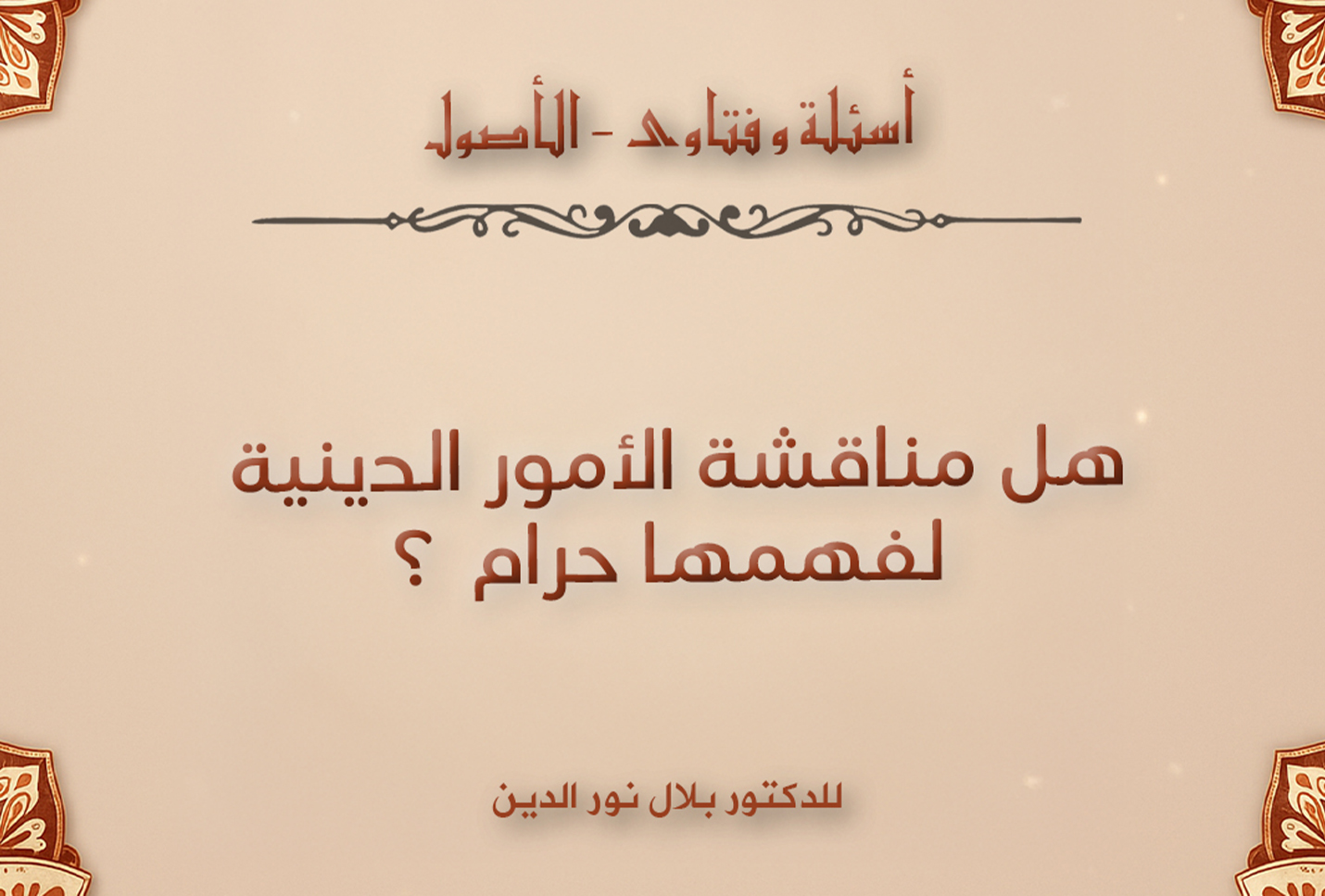فوائد من سورة الإنسان
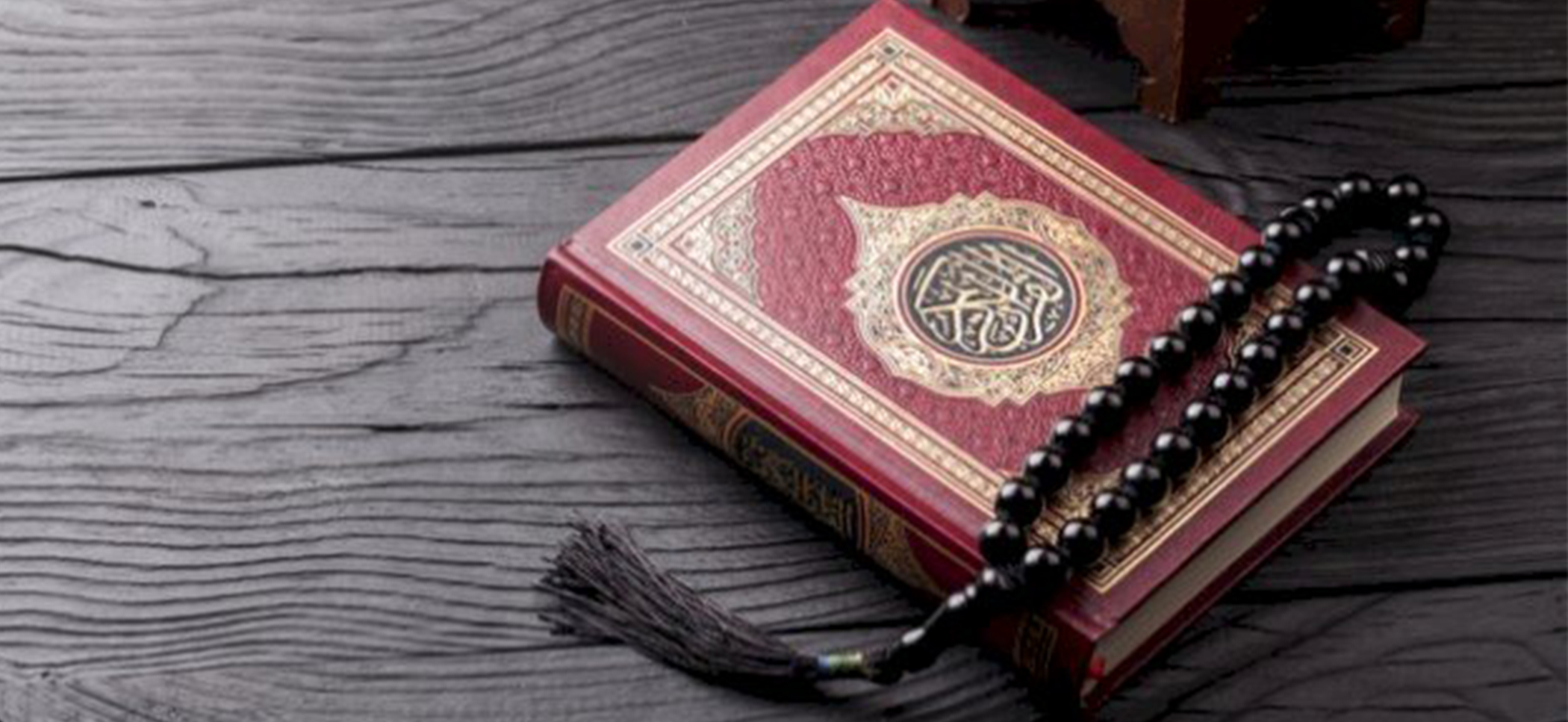
- تدبر القرآن الكريم
- 2025-09-29
فوائد من سورة الإنسان
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
| بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. |
| اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزِدنا عِلماً وعملاً مُتقبَّلاً يا ربَّ العالمين. |
| اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعِلم، ومن وحول الشهوات إلى جنَّات القُربات. |
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا(1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا(2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(3)(سورة الإنسان)
النِعَم التي لا تُحصى تندرِج تحت ثلاث نِعَمٍ كُبرى:
| افتُتِحَت السورة بذكر ثلاث نِعمٍ من نِعم الله تعالى على الإنسان، والحقيقة أن النعم كثيرة: |
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(18)(سورة النحل)
| لكن هذه النِعَم التي لا تُحصى، تندرِج تحت ثلاث نِعَمٍ كُبرى ذكرتها الآيات هُنا. |
| النعمة الأولى نعمة الإيجاد، والثانية نعمة الإمداد، والثالثة نعمة الهُدى والرشاد، الله تعالى أوجدنا من عدم، هذه أول نعمةٍ أنك موجود، اليوم تقول أنا فلان الفلاني، هذه نعمةٌ أنك موجود. |
| النعمة الثانية أنك ممدود، يُمدُّك الله بالسمع، بالبصر، بعمل الكلية، بالزوجة، بالأولاد، بالأصحاب، بالسكينة أحياناً، وأحياناً بالتأديب التربوي، يُعالجك قبل أن تلقاه ليتوب عليك، حتى تصل إليه كيوم ولدتك أمك، هذا كله إمداد، والإمداد نوعان: نوعٌ جسدي ونوعٌ نفسي، وهذا مُستمد من اسم الله الربّ، الربّ هو المُمِد، والمُمِد جلَّ جلاله يمُدُّ عباده بنوعين من الإمداد. |
| النوع الأول إمدادٌ مادي: السمع والبصر إمداد، عمل الكلية إمداد، الطعام والشراب إمداد، الولد إمداد، المطر إمداد، إمدادٌ من المُمِد الربّ جلَّ جلاله الذي يُربّينا. |
| والإمداد الثاني معنوي: كيف معنوي؟ صلَّى فألقى الله في قلبه السكينة، هذا مدَد من نوعٍ آخر، معنوي، فارتاح للصلاة، فأصبح إذا فاتته الصلاة يشعُر بانقباض، هذا من إمداد الله له، ذهب إلى الحج وقف أمام الكعبة دمَعت عينه من خشية الله، إمداد. |
| الآن عصى الله تعالى فانقبض، إمداد ليُشعره الله تعالى بأنك دائماً ابقَ قريباً منّي لا تبتعد، إمداد، كما يفعل ربُّ الأُسرة، إذا كان يُمدّ فقط بالطعام والشراب لا يُسمّى مُربّياً، لكن إذا كافأ ابنه عند الإحسان وعاقبه عند الإساءة، أصبح ربُّ أُسرةٍ حقيقي، مربّي. |
| فربُّنا جلَّ جلاله من نِعمه الإمداد، النعمة الأولى الإيجاد، الثانية الإمداد بنوعيه المادي والمعنوي، والثالثة الهُدى والرشاد، هو نوعٌ من أنواع الإمداد، لكن يُفرَد لأنَّ له أهميةً خاصة، حتى لا يُظَن أنَّ هو شيءٌ بسيط، فيُفرد بالذِكر وهو نعمة الهُدى والرشاد، أنه هدانا، قال لك: هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الحقّ وهذا طريق الباطل، هذا طريق الهُدى وهذا طريق الضلال، هذه هداية، هداه: |
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ(49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ(50)(سورة طه)
النعمة الأولى نعمة الإيجاد:
| فهذه الآيات الأولى من سورة الإنسان، ذكرت هذه النِعَم الثلاث بشكلٍ رائعٍ جداً وبليغٍ جداً، النعمة الأولى الإيجاد، قال: (هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) ما يُذكر، أنت اليوم فتحت كتاباً قديماً، اطلعت على تاريخ طباعته طُبِع عام 1940، أنا مواليد 1970 عندما نُضِّدت حروف هذا الكتاب وطُبِع أين كنت أنا؟ من كنت؟ لا شيء (لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) لم يكن يُذكَر بين الناس، لم يكن يُعهَد أنه فلانٌ بن فلان، فهذه النعمة الأولى، وذكرها المولى جلَّ جلاله مُفتَتِحاً بها بأسلوب الاستفهام، لأنَّ أسلوب الاستفهام أوقع في القلوب من الحقيقة المباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه: |
{ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط }
(رواه مسلم)
| أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم، فتَضْرِبوا أعناقَهُم، ويَضْرِبوا أعْناقكُم؟!، قالوا: بَلَى، قال: ذِكْرُ اللهِ |
{ أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم، فتَضْرِبوا أعناقَهُم، ويَضْرِبوا أعْناقكُم؟!، قالوا: بَلَى، قال: ذِكْرُ اللهِ }
(أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد)
{ أَرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهْرًا ببَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ؟ قالوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بهِنَّ الخَطَايَا }
(أخرجه البخاري ومسلم)
أسلوب السؤال والاستفهام أحياناً من الأساليب العربية التي تُنبِّه المُستمِع:
| فالله تعالى يستخدم، وأسلوب السؤال أحياناً والاستفهام من الأساليب العربية التي تُنبِّه المُستمِع (هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ) سؤال، السؤال بعُرف الإنسان يحتاج إلى جواب، الاستفهام التقريري لا يحتاج إلى جواب لكنه يُنبهك فيدعوك إلى التأمُّل، ما معنى استفهام تقريري؟ أي فحوى الآية: (أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) ليُقرِّب الحقيقة جلَّ جلاله جاء بطريقة الاستفهام (هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) فتقول: نعم والله أتى، مَن أنا قبل مئة سنة؟ مَن أنا قبل سبعين سنة؟ ما كنت شيئاً مذكوراً، الله تعالى جعل لي الذِكر، جعلني أباً، جعل لي أصدقاء ورفاق، يقولون: فلان، فألتفِت نعَم، (لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا) هذه النعمة الأولى نعمة الإيجاد. |
النعمة الثانية الإمداد:
| النعمة الثانية الإمداد: قال (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ) بدأ الإمداد من لحظة النطفة، النطفة لا تُرى بالعين المُجردة، البويضة كرأس الدبوس، بلقاء الزوجة انطلقت ملايين الحيوانات المنوية، واحد منهم وصل إلى البويضة، لقَّحها فتَكوَّن بداية الجنين: |
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2)(سورة العلق)
| النطفة أصبحت علقة، علقت بجدار الرحم، العلقة مُضغة، مُخلَّقة وغير مُخلَّقة، صار التمايُز، كل خلايا اتجهت لتشكيل شيء، خلايا للجهاز العصبي، خلايا للجهاز الهضمي، خلايا للأطراف، بدأت بعض الخلايا تُضحّي تضحية عجيبة، تموت فتتشكل الأصابع، تصل إلى هُنا فتتوقف، تتشكل الأصابع، الذي يُتابع فيلم مُصوَّر بشكلٍ سريع عن مراحل تخلُّق الجنين، يسجُد خاشعاً لله تعالى، كيف؟ قال: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ) عندما يتفكَّر الإنسان في خلقه، قال تعالى: |
وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ(21)(سورة الذاريات)
| يجد العجَب العُجاب، والقرآن الكريم أعطانا قواعد عامة للتفكُّر في خلق الله، القاعدة الأولى: قال تفكَّر في الشيء وأصله (خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ) انظر إلى ابنك أمامك، عمره خمس أو عشر سنوات، انظر إليه أين كان قبل عشر سنين؟ لم يكن موجوداً، هذا الدماغ الذي يُفكِّر ويعقِل ويتفكَّر، بدأ يكتُب ويُطابق، وعينان وعدسة، جميعهم ما أصلهم؟ نطفة لا تُرى بالعين المُجردة، أصبحوا جهاز عصبي، وجهاز هضمي وجهاز طرح كلية، وجهاز بولي، ودماغ، ومُخ ومُخيخ، وبصلة سيسائية، ونُخاع شوكي، وتوازن، ومَشيَ، وكَبِر، وتكلَّم، وكل حرف سبع عشرة عضلة للنطق به تُساهم بتشكيله، ما أصله؟ قال: (خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ) النطفة التقت مع البويضة، هُنا ما قال من نطفة، طبعاً هناك آيات أُخرى: |
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ(46)(سورة النجم)
الغشاء العاقل:
| لكن هُنا قال: (مِنْ عَلَقٍ) لأنه أول مرحلة يتشكل بها المخلوق، عندما يعلق بجدار الرحم، في آياتٍ أُخرى (مِن نُّطْفَةٍ) الأصل قبل، فقال: (إنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ) أي متداخلة النطفة مع البويضة أمشاج، ثلاث عشرة صِبغي أو أكثر لا أدري، من الزوج والزوجة (نَّبْتَلِيهِ) أصل الخَلق هو الامتحان، الابتلاء لنرى موقفه (فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) الإمداد، كله إمداد من الله تعالى، من اللحظة الأولى للخلق، العلقة تحتاج إمداد فتأخذ غذاءها من الرحم، الجنين في بطن أمه يتعلَّق بالحبل السري، يدخل إلى المشيمة التي هي القرص اللحمي الذي يصل بين الأم وجنينها، يدخل إليه دورة دم الأم، ودورة دم الجنين، يلتقوا مع بعض ولا يختلطان، لأنَّ بينهما غشاءً سمّاه العلماء الغشاء العاقل، لماذا سمَّوه الغشاء العاقل؟ قال الأطباء: لأنه يقوم بمهماتٍ لو أوكِلَت إلى أمهر الأطباء لمات الجنين خلال ساعة. |
| طيلة هذه الفترة دورة الأم دخلت ودورة الجنين دخلت، كغشاءٍ بينهما حاجز، عوامل المرض من الأم لا تنتقل إلى الجنين، لكن عوامل المناعة تنتقل، ما عنده جهاز للتنفس، جزء من زفير الأم هو نَفَس الولد، الهواء الذي يستنشقه الولد، ما عنده جهاز هضم، يأخذ الغشاء العاقل كل ما تأكله الأم من فيتامينات وبروتينات، بنسبٍ مدروسة ويدخلها إلى دورة دم الجنين، فهذا الغشاء يقوم بعمل جهاز تنفُّس، وجهاز هضم، وجهاز مناعة، كله يأخذه من الأم ويضعه بالجنين، ويسحَب من الجنين للأم النواتج، فسمَّوه الغشاء العاقل، لأنَّ الأعمال التي يقوم بها يعجز عن القيام بها أمهر الأطباء. |
يبدأ الإمداد من اللحظة الأولى لخلق الجنين:
| فبدأ الإمداد من اللحظة الأولى لخلق الجنين (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) السمع قبل البصر للجنين، الجنين في بطن أمه يبدأ يسمع، لذلك ينصح الأطباء المؤمنون المرأة أن تقرأ وتسمع القرآن في البيت، الطفل يتعرَّف لصوت أُمه وهو في بطنها، لكن البصر يكتمل بعد الولادة بأسابيع، لكن لا يحتاجه في البطن، لكنه يسمع، قال: (فجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) بالترتيب، هذا إمدادٌ من الله تعالى، وجاء بالسمع والبصر لأنها المنافذ إلى العالَم الخارجي، هو لو أدخل معلوماتٍ صحيحة بسمعه، وصورٍ ببصره، وعالج معالجة صحيحة بعقله، فيُخرِج مُخرجاتٍ صحيحة. |
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ(10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ(11)(سورة الملك)
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا(36)(سورة الإسراء)
إذا كانت المُدخلات صحيحة والمُعالجة صحيحة فالنواتج صحيحة:
| أي المُدخلات والمُعالجة مسؤولٌ عنها، لأنَّ المُدخلات إذا كانت صحيحةً والمُعالجة غلط، تخرُج المُخرجات غلط، أمّا إذا المُدخلات صحيحة والمُعالجة صحيحة فالنواتج صحيحة. |
| هو نظر إلى الشجرة، مُدخَل، من خلقها؟ الله، فالمُخرَج صحيح، إذاً سأؤمن بالله تعالى، فالمعالجة صحيحة. |
| هناك أُناسٌ يجلسون في وكالة ناسا للفضاء، يرون آيات الله واضحةً صارخة أكثر مني ومنك، يُدخلها ويُعالجها غلط فيخرُج معه أنَّ الكون صُدفة، فتقول: كيف ذلك؟! لأنه لا يوجد قرار بالإيمان. |
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(248)(سورة البقرة)
| الآية تدعو إلى الإيمان، إذاً كيف الإيمان قبل الآية؟ نحن نرى الآية فنؤمن، وهُنا الآية تقول العكس: (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) يعني إذا كان هناك قراراً بأن يوصلني هذا الكون إلى الخالق، ستنفعني الآية بتثبيت الإيمان، أمّا مَن ينظُر إلى الآيات الكونية وليس عنده قرار بالإيمان، يريد أن يبقى مُتفلِّتاً كما يُحب، يريد أن تبقى لديه المساحة مفتوحةً مئةً وثمانين درجة، بالنساء وبالمال وبالشهوة، فلن توصله الآيات إلى الله تعالى. |
| لذلك الإيمان سرّ، يقول إنسانٌ: كلنا رأينا عظمة الله في الكواكب والنجوم، كيف هذا اهتدى ودمعَت عينه، وفلانٌ قال لك: عادي صُدفة! كيف استقامت معه صُدفة؟! هل يستقيم معه إذا قلنا له: هناك مطبعة حدث فيها انفجارٌ فخرج منها القاموس الإنكليزي المورِد، وترتَّبت حروفه لوحدها! يقول لك أعوذ بالله! تحتاج لمن يقوم بتنضيدها حرفٌ بعد حرف، لكن يستقيم معه بأنَّ الكون كله بما فيه من تجاذباتٍ صُدفة، لأنه لا يوجد قرار، لأنه منصرفٌ عن الله، فقال: (فجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) هذه النعمة الثانية وهي نعمة الإمداد من الله تعالى. |
النعمة الثالثة نعمة الهُدى والرشاد:
| النعمة الثالثة: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) نعمة الهُدى والرشاد، الله تعالى هدى الإنسان السبيل، كل الناس هداهُم السبيل، الهداية هي الدِلالة، نحن نفهم الهداية هداية التوفيق، أي الهداية الأُخرى، النتيجة، تقول: فلانٌ مُهتدي وفلانٌ ضال، قبل ذلك الهداية هي الدِلالة، أنت الآن إذا وقفت في الطريق على مفترق الطرُق ووجدت إنساناً، قلت له الطريق إلى عبدون من هُنا أم من هُنا؟ مُجرَّد ما قال لك من هُنا وهو ثقةٌ عندك، فهو قد هداك، لكن أنت لو اتجهت بالعكس فتلك مشكلتك، أنت لم تهتدِ لكن هو هداك، فربُّنا عزَّ وجل بمُجرَّد أنه خلق الكون الذي يدل على وجوده، وأعطى العقل الذي لو أعمله الإنسان، لاستدلَّ على وجود خالقٍ للكون، وأعطاه الفطرة السليمة التي فُطِر عليها، بحيث يشعر بالارتياح للخير وبالانزعاج من الشر. |
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ(7)(سورة الحجرات)
| بمُجرَّد هذه الثلاثة هو هداك جلَّ جلاله. |
الإنسان مُخيَّر:
| الآن أرسل الرسُل إذاً هناك منهج، تلك هدايةٌ عامة، أنزل الكتُب هدايةٌ أكثر وأكثر، فالله هدانا، الآن هناك من اهتدى وهناك من لم يهتدِ، هو سارَ في الطريق أو لم يَسِر، قال: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) للإنسان وليس للمؤمن، وتركنا له الخيار بعد الهداية (إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) هذه الآية تؤكد أنَّ الإنسان مُخيَّر، أيُّ آيةٍ تقرأُها غير هذه الآية أو حديثٍ توهمك أنَّ الإنسان مُجبَر، قِسها على هذه الآية، لأنَّ هذه الآية مُحكمة أمّا تلك التي أوهمتك متشابه، والمتشابه يُحمَل على المُحكَم، هذه الآية واضحة لا تحتمل تفسيرين، أمّا الأُخرى تحتمل، أي: |
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ(31)(سورة يونس)
| نُفسرها بضوء هذه الآية، هذه تقول: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)، (لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا) لماذا لم يهدِ الناس جميعاً؟ لأنه لا يريد لنا الهُدى الإجباري، لأنه لا يرقى بنا، يريد الهُدى الاختياري، إذاً هي تؤكد الاختيار، أمّا الملائكة فشاء الله أن يهديهم جميعاً بالقسر: |
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(6)(سورة التحريم)
| أنت مخلوقٌ مُمَيز، نوعٌ آخر، أنت معك اختيار (إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا). |
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(30)(سورة الإنسان)
| نعم أنا لا يمكن أن أهتدي إلا أن يوفقني الله إلى الهداية، أنا لا أهتدي بنفسي. |
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ(17)(سورة محمد)
| إذاً هذه الآية تتحدث عن هداية التوفيق، دلَّني على الطريق، مشيت به، أعطاني التفاصيل وأوصلني، لم أمشِ به فهذه مُشكلتي، فالله تعالى هدى عباده جميعاً دِلالةً، ومن اختار منهم الهُدى وفَّقه إليه، ومَن زاغَ: |
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5)(سورة الصف)
الشُكر علامةٌ على الإيمان:
| ليتحقق الاختيار نحن مُخيَّرون، وهذه الآية واضحة في التخيير (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) ولمّا كان المجال ذكر النِعَم، نعمة الإيجاد والإمداد، فناسب أن يأتي الشُكر معها، يعني ما قال إمّا مؤمناً وإمّا كفوراً، بل جاء بالشُكر لأنَّ الشُكر علامةٌ على الإيمان، فشاكراً يعني أنه مؤمن، ولولا أنه مؤمن لما شَكَر، لكن ليُناسب مقام النِعَم، هو ذَكر له النِعَم، ردُّ فعله على النِعَم الشُكر، فقال: (إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) إذاً الأول مؤمنٌ، والثاني كافر، والكافر جاحد لا يشكُر، والمؤمن شاكر، فبكلمتين يُعطيك أربعة، وهذا أسلوبٌ عربيٌ بليغ، قال تعالى: |
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ(13)(سورة آل عمران)
| إذاً التي تقاتل في سبيل الله مؤمنة، والكافرة تقاتل في سبيل الشيطان، فهذا أسلوبٌ عربي بأنه يأتي بكلمتين كل واحدةٍ تدل على أُخرى، فيُعطيك الكلمتين الثانيتين حُكماً، أمّا لو قال واحدة مؤمنة والثانية كافرة، لما جئنا بالدلالة واحدة تقاتل في سبيل الله والثانية في سبيل الشيطان، ولو قال تقاتل في سبيل الله والأُخرى تقاتل في سبيل الشيطان، لما استدلينا أنها مؤمنة وكافرة، فقال: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) وهذه الآية أصلٌ في التخيير، فأيُّ إنسانٍ يقول لك: أنا توهمت أني مُجبَر لأنَّ الحديث يقول كذا، قُل له: نحن عندنا آيةٌ مُحكمة، ربُّنا يقول: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) فربُّنا عزَّ وجل منحنا الخيارين، لا أحد يقول أنا مُجبَر. |
| لمّا أعطى الله تعالى هذه النِعَم الثلاث وبيَّنها، ناسب أن تكون بعدها النتائج، يعني شاكراً أو كفوراً لكن هناك نتيجة، أنا في الصف قلت للطلاب من يُحب أن يدرُس فليدرُس، ومَن لا يُحب أن يدرُس فلا يدرُس، لكن في النتيجة من يدرُس ينجح ومَن لا يدرُس سيرسُب هذا وضعٌ طبيعي، فقال: |
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا(4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا(5)(سورة الإنسان)
| والكافور نباتٌ عطريٌ معروف غالي جداً، له فوائد والإكثار منه له مشاكل، لكن هنا ليس المقصود الكافور الذي نعرفه في الدنيا، وإنما المقصود النعيم، يعني البرودة والنعيم، شيءٌ نعرفه من الدنيا، قال: |
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا(6)(سورة الإنسان)
| العين يشرب الإنسان منها وليس بها، لكن هذه الكلمة ضُمِّنَت معنى الارتواء فيرتوي بها، هذا تضمينٌ باللغة (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا). |
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا(7)(سورة الإنسان)
النذر المشروط مَنهيٌ عنه:
| النذر هنا ليس المقصود به مُجرَّد أنَّ إنساناً قال: نذراً عليَّ لله أنا أذبح خروفاً فأوفى به، لكن هذا جزءٌ من النذر، وبالمناسبة النذر بما يفعله كثيرٌ من الناس مَنهيٌ عنه، وهو النذر المشروط، يقول مثلاً: إن شفاني الله سأتصدق، إن نجح ابني في الامتحان سأذبح خروفاً، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا النوع من النذر: |
{ نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وقالَ: إنَّه لا يَرُدُّ شيئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيلِ }
(صحيح البخاري)
| الكريم لا يشترط على ربنا، الكريم يقول هذه الدفعة وإن شاء الله ربّي يشفيني، على نية الشفاء، لا يقول إذا شفاني أدفع، ربُّنا لا يُجرَّب، ادفع لن يضيع شيئاً، إذا صار الشفاء صار، وإذا ما صار الشفاء صار ما هو أعظم منه يوم القيامة، فالنبي نهى عن النذر المشروط الذي يتعاهد عليه الناس، أمّا النذر غير المشروط،، نذراً عليَّ لله أن أفعل كذا، إذا كان قادراً عليه فلا مشكلة لكن هُنا المقصود (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) يعني بشكلٍ عام، بأوسع ما يعقِد الإنسان العزم عليه، عقد العزم على الصلاة، على العبادة، على الطاعة: |
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ(172)(سورة الأعراف)
| هذا نذرٌ نذرناه على أنفسنا أن نعبُد الله تعالى، فالمفهوم واسع (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) مُنتشر الشر هناك كثيرٌ على المجرمين والعياذ بالله. |
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا(8)(سورة الإنسان)
| على حُبِّ الله تعالى معنىً، يُطعمون الطعام حُبّاً بالله، ويُطعمون الطعام على حُبِّهم للطعام، أي معه طعامٌ وهو يُحبُّه لكنه رأى فقيراً فقال هو أَولى منّي، فعلى حُبِّ الطعام أو على حُبِّ الله تعالى جلَّ جلاله. |
الصدقات وإطعام الطعام يجوز لغير المسلم:
| (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) يعني جاء بأنواعٍ ثلاثة، وهذه الآية استُدِلَّ بها على أنَّ الصدقات وإطعام الطعام يجوز حتى لغير المسلم، لأنَّ الأسير غير مسلم، والله تعالى أمر بالإحسان إلى الأسير، والإطعام له صدقةً وليس زكاةً، لأنَّ الزكاة هي نظامٌ تكافلي إسلامي، يؤخَذ من أغنيائهم ويُردُّ على فقرائهم، أمّا الصدقات والتبرُّع هذا الأمر فيه واسع، فيُعطى منه شخصٌ غير مسلمٍ، يُطعَم ولك الأجر (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا). |
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا(9)(سورة الإنسان)
| يمكن قلتها سابقاً ربُّنا هُنا قال: (لَا نُرِيدُ مِنكُمْ) ما قال: لا نريد جزاءً ولا شكوراً، لأنني أقول دائماً، لا يوجد إنسانٌ يفعل عملاً صالحاً لا يريد منه شيئاً، وأنا أوَّلهم، إمّا أنه يريد الناس أن ينظروا له نظرة إعجابٍ ويقولوا أنفَق، ممكن، وإمّا أنه يريد أن يُكافئه أحد بمبلغٍ أكبر، ممكن، وإمّا أنه يريد أن يُحصِّل منصِب بعد حين لأنَّ هناك انتخابات، ممكن، وإمّا أنه يريد وجه الله تعالى، لكنه يريد شيئاً، فقال: (لَا نُرِيدُ مِنكُمْ) أنتم منكم لا نريد شيئاً، لا سُمعةً، ولا رياءً، ولا مُكافئةً (جَزَاءً) أي عطاءً مقابل عطاء، أنا هديتك فاهديني، لا (وَلَا شُكُورًا) أي حتى كلمة شُكراً لا نريدها. |
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ(24)(سورة القصص)
| عندما تساعد إنساناً لا تنتظر حتى يقول لك شُكراً، بل تولَّى إلى الظل بحيث لا يراك (فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) أنا فقيرٌ لعملٍ صالحٍ، وهذا خير كبير سُقته إليّ، أنا مُفتقر. |
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا(9) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا(10)(سورة الإنسان)
| شديد السواد، شديد الظلام والعياذ بالله، هذا اليوم الحالك الذي ينتظر المجرمين، نحن خائفون من هذا اليوم، فعملنا حُبَّاً بالله، وخوفاً من عذاب الله، نُعدُّ لهذا اليوم عُدَّته، قال: |
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا(11)(سورة الإنسان)
| لمّا خافوا وقاهم، الشر المُستطير (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) تخلية وتحلية، نضارة، يقول لك: نباتٌ نَضِر، أخضر بلونٍ فاقعٍ (نَضْرَةً وَسُرُورًا). |
وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا(12)(سورة الإنسان)
أن يُعطي الإنسان ولا ينتظر مقابلاً في الدنيا تحتاج إلى صبر:
| هذه باء السبب، صبروا على ماذا؟ صبروا على الدنيا بما فيها، و صبروا على الجزاء والشُكور، أي أن يُعطي الإنسان ولا ينتظر مقابلاً في الدنيا تحتاج إلى صبر، لأنه سيتأخر العطاء، العطاء ليس مباشرةً، ربما تصبر العمر كله، يحتاج إلى صبر. |
وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا(12) مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا(13)(سورة الإنسان)
| لا بردٌ شديد ولا حرٌّ شديد اعتدالٌ مستمر. |
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا(14)(سورة الإنسان)
| مُذللة، أي خاضعةً له، نحن أحياناً إذا أردنا أن نقطف يجب أن نصعد على السُلّم، أمّا هُنا تأتي إلى عنده. |
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا(15) قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا(16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا(17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا(18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا(19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا(20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا(21) إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا(22)(سورة الإنسان)
| أنتم لم تطلبوا جزاءً ولا شكوراً، فانظروا إلى الجزاء والشكور عندما يأتي من الله، أنت قلت له لا أُريد منك شيئاً، إن شاء الله لوجه الله ولا تذكرني لا بإعلامٍ، ولا أُريد صورةً وأنا أُعطيك، لا أُريد شيئاً، سقيت ثم توليت إلى الظل، لا جزاءً ولا شكوراً منكم، فكيف كان منه الجزاء والشكور جلَّ جلاله؟ كل هذا الذي ذكرناه وأكثر. |
{ قالَ اللَّهُ: أعْدَدْتُ لِعِبادِي الصَّالِحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَرٍ }
(صحيح البخاري)
| ختمها فقال: (إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا) أي أخذتم الجزاء وأخذتم الشكر من الله تعالى. |
| فهذا غيضٌ من فيض، مما في سورة الإنسان من المعاني العظيمة التي يُنتبه لها، طبعاً في ختام السورة ربُّنا جلَّ جلاله تحدَّث عن المنهج: |
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا(23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا(24)(سورة الإنسان)
لو جاء حُكم ربنا كما نشتهي دائماً لا نحتاج صبر:
| أُريد أن أُعلِّق على هذه الآية: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) معناها أنَّ حُكم ربُّنا عزَّ وجل يمكن أن يكون ليس كما تريد فيحتاج إلى صبر، أي لو جاء حُكم ربنا كما نشتهي دائماً لا نحتاج صبر، أنا أُريد مالاً وحُكم ربّي أنَّ المال كثير، أنا لا أُريد أن أفقِد أحداً في الدنيا وحُكم ربّي أن لا تفقد أحد، تعيش حياتك كلها مع أحبابك وتموتوا معاً فلا تحزن، أنا أُريد منصباً وحُكم ربُّنا أن تكون بأعلى منصِب، أنا أُريد جاهً وحُكم ربُّنا أن يكون عندي جاه، أُريد مزرعةً وحُكم ربُّنا أن يكون عندي مزرعة، فلم يبقَ صبر ولم يبقَ جنَّة (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) إذاً وطِّن نفسك أنَّ حُكم ربك قد يكون أحياناً بخلاف ما تشتهي وتتمنى، فوطِّن نفسك أن تصبر لهذا الحُكُم. |
| وبالمناسبة وبأعمق من ذلك حتى لو جاء حكم ربنا كما نشتهي، فإنه يحتاج صبراً، فلو أنا أُريد المال وربُّنا جاء لي بالمال فلو لم أصبر على المال، ربما أُنفقه في الحرام، فحتى صاحب المال لا يعني أنه لا يحتاج إلى الصبر، فحكُم الله يحتاج دائماً إلى الصبر، سواءً جاء بما تتمنى أو بخلاف ما تتمنى، لكن لا شك أنه بخلاف ما تتمنى، يكون بحاجةٍ إلى الصبر الأعظم، لاسيما عند الصدمة الأولى، قُل لإنسانٍ مثلاً: تلِف بعض مالك، أو توفي قريبك الذي تُحبُّه أو كذا، يعني يحتاج إلى أن يتماسك، وأن يرضى بما قسم الله وبما قدَّر الله. |
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا(24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا(26)(سورة الإنسان)
| اذكُر ربَّك صباحاً ومساءً، قيام الليل وصلاة الفجر، وصلاة العشاء والوتر، كل هذا من صلاة الليل. |
إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا(27)(سورة الإنسان)
| يحبون العاجلة أي الدنيا، هؤلاء الذين قبلهم أحبّوا الآجل فقالوا: (لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) لأنهم يؤمنون باليوم العبوس القمطرير، يرونه وكأنهم يرونه بأعينهم. |
إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا(27) نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا(28) إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا(29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(30) يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(31)(سورة الإنسان)
الدعاء:
| اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم انصُر أهلنا في غزَّة، وفرِّج عنهم فرجاً عاجلاً، وأكرمهم وأطعِم جائعهم، واكسُ عريانهم، وارحم مُصابهم، وآوِ غريبهم، واغفر لنا تقصيرنا فإنك أعلم بحالنا، وهيئ لنا سبيلاً لنصرتهم يا أرحم الراحمين. |
| اللهم إنك أعلم بحالنا ولا يخفى عليك ذلُّنا بين يديك، ولا يخفى عليك تآمُر القريب والبعيد، فنسألك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، أن تُرينا عزّ الإسلام والمسلمين، وقهر الظلم والظالمين، إنك وليُّ ذلك والقادر عليه، بارك البيت وأهله، وأطعِم من أطعمنا، بارك لأخينا أبا يزن في أهله وماله وولده وعياله، ووفِّقه لكل خيرٍ، وألهمه كل خير، وصلِّ وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. |