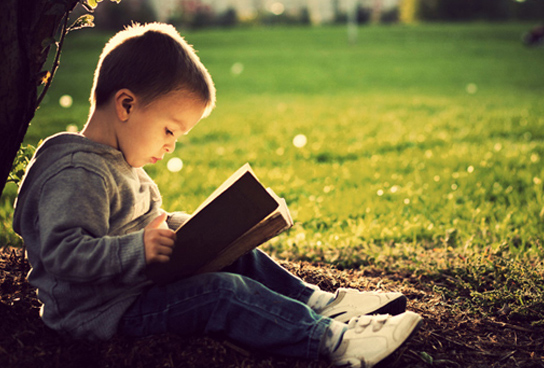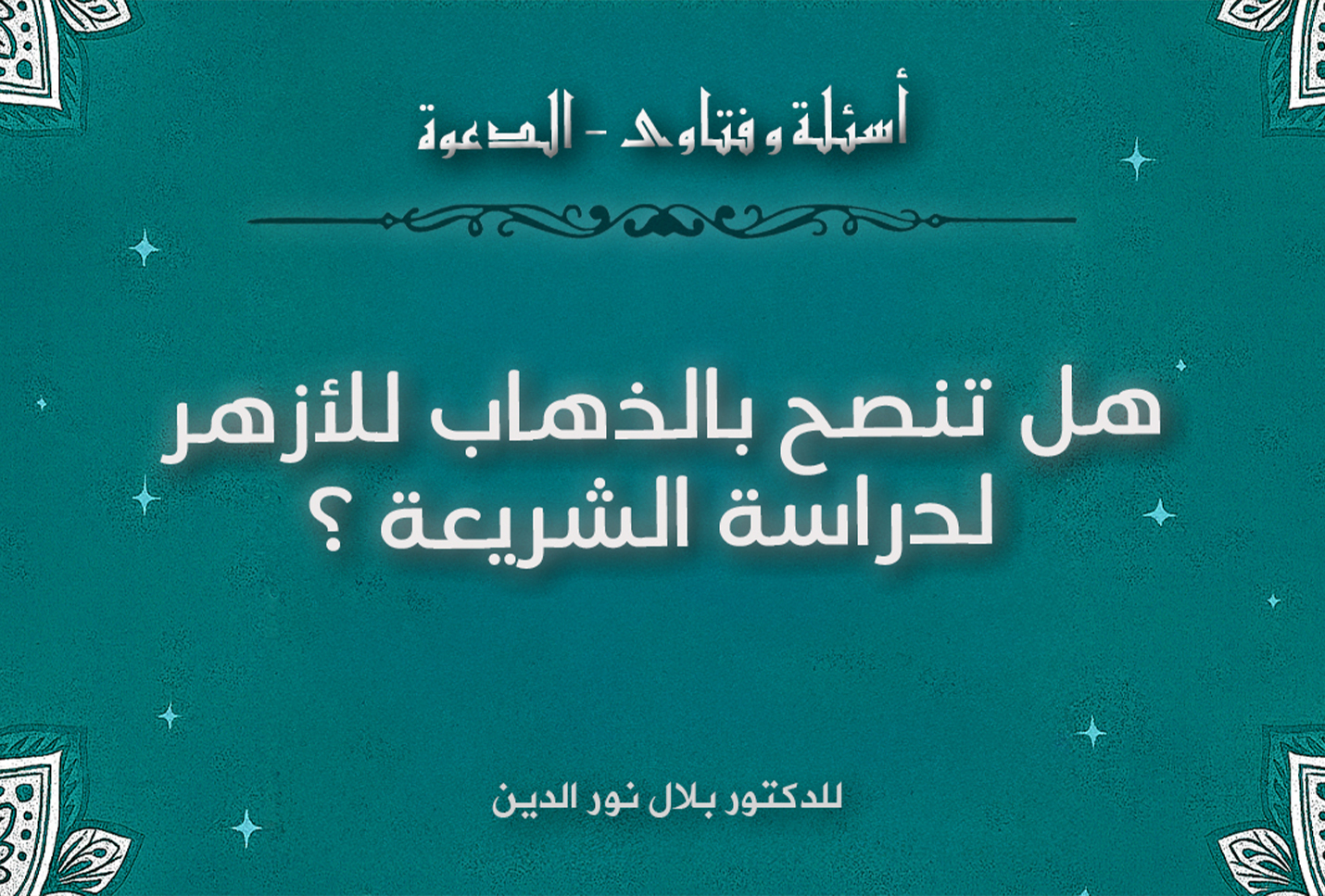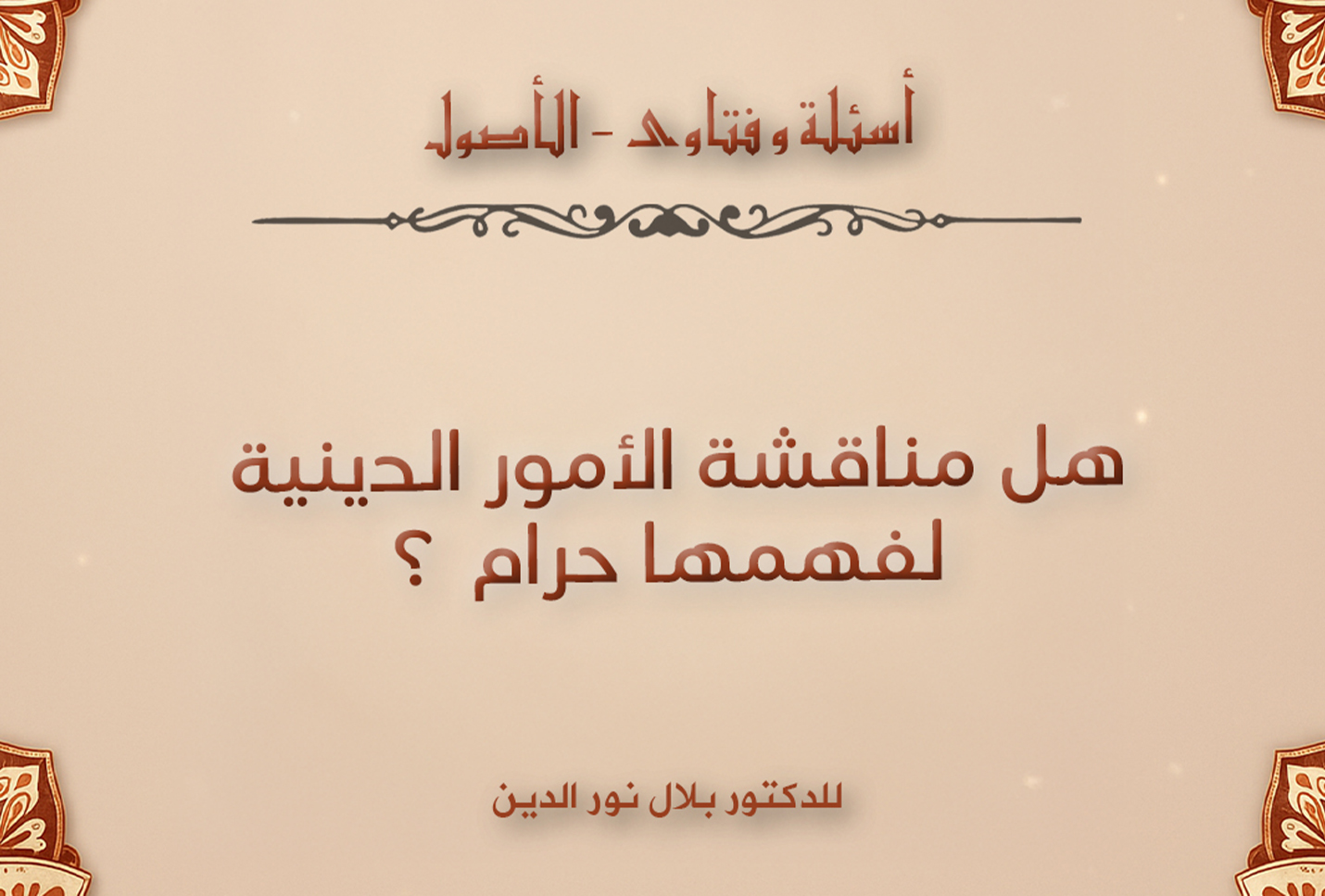سورة الأنبياء: الابتلاءات الخاصة بالأنبياء
سورة الأنبياء: الابتلاءات الخاصة بالأنبياء
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
| مُستمعينا حيَّاكم الله وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج التفسير نوافذ دينية، والذي مازال الحديث فيه عن أنوار وتأمُّلات سورة الأنبياء، فتعالوا بنا مُستمعينا لمعين هذه السورة الجليلة. |
مقدمة:
| إخوتي الكرام: حين تفتح قلبك لسورة الأنبياء، لا تقرأ أحداثاً ماضية، بل تسمع صوت الوحي يُخبرك أن لكل نبيٍ في هذه السورة مقاماً، ولك ابتلاءٍ فيها مغزى، ولك دعاءٍ فيها طريقاً مفتوحاً إلى السماء، هي سورة النبوَّة الكُبرى والمقام التوحيدي الجليل، جمعت أنفاس الأنبياء وسطور التضحيات، لتكون للعالمين آيةً على صدق الوعد وسموّ المقصِد. |
| مُستمعينا دعونا نُكمِل الحديث عن أنفاس الأنبياء، وعن دعواتهم، وعن استجابة الله لهم، حتى أنَّ هذه السورة سُمّيَت بسورة الاستجابة. |
| فرحِّبوا معي مُستمعينا الأفاضل بفضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز العلمي في القرآن والسُنَّة، عضو رابطة علماء الشام، والمشرف العام على الموقع الرسمي للعالِم الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي. |
| حيَّاكم الله دكتور وأهلاً ومرحباً بكم. |
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم ونفع بكم وشكراً لهذه الاستضافة الكريمة. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| أهلاً بكم دكتور، في سورة الأنبياء والتي تحدثت فيها في أسابيعٍ سابقة، توقفنا في حديثنا عند الحديث عن عدل الله المُطلَق، تحدَّثنا عن الحساب، عن الوعد والوعيد، تحدَّثنا عن الفُرقان الذِكر، ربطنا صفات المُتقين بخشية الله في الغيب، اليوم نأتي لنُخصِّص هذه الحلقة عن ذِكر الأنبياء في سورة الأنبياء، تقدَّم الحديث عن بلاغة وإعجاز القرآن الكريم حين ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء بغير ترتيبٍ زمني، فذكر مثلاً إبراهيم قبل نوح عليهما السلام، وهكذا، وبيَّنا الإعجاز في ذلك، اليوم يا دكتور نتحدث عن الآيات والتي تختص بسيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم لم يكن خصماً للوثنية فقط، بل حُجةً حيةً على فسادها، فجاء التهديد بالنار فكانت برداً وسلاماً، نودّ بيان أنَّ من صدق مع الله فإن نار القوم ونار الدنيا ينجو منها، فالقلوب الموحِّدة لا تحترق، زِدنا من علمكم بارك الله بكم. |
الدكتور بلال نور الدين:
| بسم الله الحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه وبعد. |
| كما تفضَّلتم سورة الأنبياء فيها روحٌ ونَفَسٌ من أنفاس الأنبياء، عليهم صلوات ربّي وسلامه، ويبدأ ذكر الأنبياء بشكلٍ مُفصَّل في السورة بقوله تعالى: |
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ(51)(سورة الأنبياء)
إبراهيم عليه السلام لم يكن فرداً بل كان أمة:
| وتأخذ السورة هُنا مقطعاً من قصة إبراهيم عليه السلام، وهو المُتعلِّق بتحطيم الأصنام، وبناء الإيمان، والتوحيد في نفوس قومه، والله تعالى عندما وصف إبراهيم عليه السلام قال: |
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(120)(سورة النحل)
| فهو عليه السلام قد حوَّل مسار أُمةٍ كاملة، من ذل الشرك إلى عز التوحيد والعبودية، فهو لم يكن فرداً واحداً، وهذا يُعلِّمنا أنَّ كُلَّ واحدٍ منّا لا ينبغي أن يكتفي بنفسه، أو أن يكون فرداً، أو أن يؤثِر أن يكون صالحاً فحسب، وإن كان هذا مطلبٌ شرعي، ولكن المطلوب أن نكون مُصلحين، وأن ننتقل من الصلاح إلى الإصلاح، فإبراهيم انطلق من ذاته إلى هِداية خلق الله تعالى، إلى هِداية قومه، فكان أُمةً، وما تزال الأُمة إلى يومنا هذا تذكره في كل صلاةٍ، فنقول: "اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" فعلاقتنا بنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، علاقةٌ مستمرة، وعلاقةٌ وثيقة، فهذا النبي الكريم بدأ بهدم الآبائية |
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ(53) قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ(54)(سورة الأنبياء)
| التقاليد والعادات، وما وجدنا عليه آباءنا، وما تربّينا عليه، وأعرافُنا وتقاليدنا، هذه كلها إذا كانت مُعارِضةً لشرع الله فلا ينبغي الاستمرار فيها، قال: (لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) فعلَّمنا هُنا إبراهيم عليه السلام، أن نبدأ بهدم الأفكار المغلوطة، ثم نبدأ ببناء الأفكار الصحيحة. |
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(256)(سورة البقرة)
| فبعد أن فاجأهُم بأنه يتعرَّض لأصنامهم ويتعرَّض لمعبوديهم من دون الله: |
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ(56)(سورة الأنبياء)
الإنسان حينما يُحسِن توجهه إلى الله يُغيِّر الله له نواميس الكون كله:
| الآن عندما توجه إلى الله وحده، وبنى التوحيد في النفوس، وعَمِل لوجهٍ واحدٍ كفاه الله الوجوه كلها، فلم تُحرقه النار لأنَّ النار مخلوقٌ من مخلوقات الله، ولا يقوم أمرُها ولا تُحرِق إلا بأمر الله: |
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ(69)(سورة الأنبياء)
| فالإنسان عندما يُحسِن التوجه إلى الله، الدرس الذي تُعلِّمنا إيّاه القصة، أنَّ الإنسان حينما يُحسِن توجهه إلى الله، يُغيِّر الله له نواميس الكون كله، لأنه أحسن التوحيد، ما تعلَّمت العبيد أفضل من التوحيد، "اعمَل لوجهٍ واحدٍ يكفِك الوجوه كلها". |
{ مَن جَعَلَ الهمَّ همًّا واحدًا همَّ المَعَادِ كَفَاهُ اللهُ سائرَ هُمُومَهُ ومن تَشَعَّبَتْ بِهِ الهُمومُ أحوالَ الدنيا لم يسأَلِ اللهُ في أيِّ أودِيَتِهَا هَلَكَ }
(أخرجه ابن ماجه والبزار والعقيلي في الضعفاء الكبير)
| فالإنسان إمّا أن يكون موحِّداً، أو أن يريد أن يرضي فلاناً وفلاناً ولن يرضى أحدٌ عنه، ثم يستحق عقوبة الله تعالى. |
| إبراهيم عليه السلام علَّمنا هذا الدرس العظيم، أنك عندما تُحسِن التوجه إلى الله، فالله يكفيك البشر كلهم، فإذا بالنار تُصبح برداً وسلاماً، ولو قال برداً، لربما تجمَّد أو عانى من البرد، لأنَّ البرد مزعج كما هي الحرارة، لكن قال: (كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) وخُصِّص بها إبراهيم عليه السلام، فالنار تُحرِق وهذه نعمةٌ من نِعَم الله تعالى، نطهو بها طعامنا، نتدفأ بها، إلى آخره... لكن الله تعالى على إبراهيم جعلها برداً وسلاماً لمّا أحسن إبراهيم التوجه، لا أقول إنَّ كل إنسانٍ يُحسِن التوجه إلى الله سيكون له معجزة، لأنَّ المُعجزات للأنبياء عليهم صلوات ربّي، لكن ستكون له معاملةٌ خاصة من الله، كرامةٌ من الله، سيرعاه الله، سيُدخِل إلى قلبه السكينة، سيحميه من شرور الخَلق، سيتولى أمره. |
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ(11)(سورة محمد)
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم، إذاً هُنا يا دكتور نحن نتحدَّث عن رسائل النبوَّة من رحم الابتلاء، خاصة في سورة الأنبياء، تتحدَّث عن ابتلاءٍ ثم تتحدَّث عن نجاة، فهذا ما تُركِّز عليه السورة في حديثها عن هؤلاء الأنبياء، لذلك عندما ننتقل لمشهدٍ آخر من مشاهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سيدنا لوط، وكان في فترة سيدنا إبراهيم عليهما السلام، كيف تحدثت الآيات عن قومٍ عكسوا الفطرة، فكان لوط ناصحاً ومصلحاً وصابراً على الأذى؟ |
الدكتور بلال نور الدين:
| بعد قصة سيدنا إبراهيم بطريقةٍ جميلةٍ جداً، تنتقل الآيات للحديث عن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. |
وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(74)(سورة الأنبياء)
فهم التاريخ يؤدّي إلى فهم الحاضر واستشراف المستقبل بشكلٍ صحيح:
| أي واذكُر لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكُر لهم هذه القصة، يجب أن يتعلموها، يجب أن يَعوا القصص والتاريخ، لأنَّ فهم التاريخ يؤدّي إلى فهم الحاضر واستشراف المستقبل بشكلٍ صحيح، لا بُدَّ من قراءة الماضي قراءة وعيٍ وتدبُّرٍ وتأمُّل، ولا سيما إذا كان هذا الماضي هو قصص الأنبياء عليهم السلام، فقال: |
وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(75)(سورة الأنبياء)
| هُنا القصة تأخذ منحى الاختصار، لتأتي السوَر الأُخرى وتُبيِّن، ما هذه الخبائث التي كانت تعملها، وكيف نجَّاه الله تعالى، فالعبرة هُنا بالقصة كما تفضَّلتم الفَرَج بعد الشدّة (وَنَجَّيْنَاهُ) التمكين بعد الابتلاء، سُنَّة الله أنَّ الأنبياء ومن بعدهم المؤمنون، والأقوام، والمجاهدون، والمقاومون، وكل الناس، أنهم يُبتلون أولاً، فيصبرون ثانياً، فيُمكَّنون ثالثاً، وهُنا لمّا سُئل الإمام الشافعي رحمه الله: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ أجاب إجابته الرائعة "لن تُمكَّن قبل أن تُبتلى" كطالبٍ يدخل إلى الجامعة فيَسأل: هل أطلُب الشهادة أم أطلُب الامتحان؟ فيُقال له: لن تأخذ الشهادة قبل أن تخضع للامتحان، فالتكريم والتمكين والعزة والرفعة تأتي بعد ابتلاءٍ عظيم، هذه سُنَّة الله. |
ما قام به قوم لوط هو خلافٌ للفطرة لذلك كانت عقوبته شديدة والإثم فيه عظيم:
| لذلك هُنا في قصة لوط عليه وعلى نبينا السلام، جاءت مختصرةً تريد أن تُبيِّن هذه النقطة تحديداً (وَنَجَّيْنَاهُ) هُنا موطن الشاهد: (مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ) ما هذه الخبائث؟ ما تفضَّلتم به بأنَّ هؤلاء الأقوام كانوا يُخالفون الفطرة، واليوم بعد أكثر من ألفٍ وأربعمئة سنة على نزول القرآن على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، نعيش هذه الآيات واقعاً، نحن مجتمعاتنا والحمد لله بخيرٍ عظيم، ونسأل الله أن تبقى، لكن العالَم اليوم يدعم الشذوذ، يدعم مخالفة الفطرة، يريد أن يُصبِح الإنسان بلا قيَمٍ وبلا مبادئ، الزِنا والعياذ بالله هو مخالفة، لكنه مخالفة لحكمٍ شرعي فاستحقَّ صاحبه حدّاً من حدود الله، لكن أن يأتي الرجُل الرجُل والمرأة المرأة، فهذا ليس خلاف شرع الله فحسب، هو خلاف الشرع حتماً لكنه ليس كذلك فحسب، وإنما هو خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. |
| لذلك كانت عقوبته أشدّ، وكان الإثم فيه أعظم، وكان التحذير منه أكبر، لأنه يخالف الإنسان فيه فطرته التي فطره الله عليها، فاليوم نحن بحاجةٍ إلى أن نعود إلى أصل الفطرة، الفطرة مُقوِّم من مقومات التكليف التي وهبنا الله إيّاها، اليوم إنسان ربما يفعل شيئاً لا يرضي الله، فيقول لك: انزعجت من الداخل، هذه هي الفطرة، إذا كان أرقى وأرقى، إن لم يستيقظ لصلاة الفجر يقول لك: أنا مُعكَّر طوال النهار، لماذا؟ يقول لك: اليوم لم أُصلِّ الفجر حاضراً، نمتُ عنها رغم أنَّ المُنبِّه أيقظني، لكني آثرت الفراش الدافئ، فهُنا ما الذي حصل؟ فطرته تحركت، لكن لمّا يألف الإنسان المعصية كما حصل مع قوم لوط عليه السلام، ويمارسها ويخرُج عن مبادئ فطرته، تُطمَس هذه الفطرة، فإذا طُمِست الفطرة فعندها كما قال صلى الله عليه وسلم: |
{ تُعرَضُ الفِتَنُ على القُلوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ سَوداءُ، وأيُّ قلبٍ أنْكَرَها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ بيضاءُ، حتى يصِيرَ القلبُ أبيضَ مثلَ الصَّفا، لا تَضُرُّه فِتنةٌ ما دامَتِ السمواتُ والأرضُ، والآخَرُ أسودَ مُربَدًّا كالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعرِفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، إلا ما أُشْرِبَ من هَواه }
(أخرجه مسلم والبزار وأحمد)
| يُصبِح المعروف عنده كالمُنكَر، بل ربما أصبح يأمُر بالمُنكَر وينهى عن المعروف، يقول لك أنتم مُتخلِّفون، لماذا لا تسمحون بهذه الظواهر الشاذة؟ لماذا لا تتركون الناس على حرياتهم؟ لماذا ولماذا إلى آخره..!! |
| فهذه الآيات الكريمة تأتي بمرضٍ يخالف فطرة الله ويستحق عقوبة الله، واليوم نواجِهَهُ ويريد العالَم أن يفرضه على أنه ثقافةٌ جديدة في مجتمعاتهم البعيدة عن الله، ونسأل الله أن تبقى أُسرُنا قلاعاً حصينةً ضده، ويُبيِّنُ كيف أنَّ الله تعالى عندما تكون العِّفة والطهارة، وينأى الإنسان بنفسه عن هذه الأجواء المُحرَّمة، فإنَّ الله يُنجِّيه من القوم الفاسقين، ثم قال: (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا) أي تخلية وتحلية، نجّيناه من القوم الظالمين، هذه تخلية انتهى منهم، لكن لم يكتفِ البيان القرآني بذلك، لكن قال: (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا) فإذا دخل الإنسان في رحمة الله تعالى فما فقد شيئاً، يا ربّي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| إذا هذه الآيات كان المقصِد فيها هو الإنكار على الباطل، هو واجبٌ علينا، وإن كنت وحيداً فالله يُنجّي أهل الإيمان من الطوفان، وهذا ما نشعُر أنَّ الآية تقصده من خلال حديثك الطيِّب يا دكتور، هنالك لفتةٌ جميلة يا دكتور قبل الحديث عن سيدنا لوط: |
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(71)(سورة الأنبياء)
| وذلك فيه الانتهاء عن حديث سيدنا إبراهيم عليهما السلام، هُنا إشارةٌ في سورة الأنبياء إلى الأرض المُباركة، وكأنها فيها تلميحات إلى أنَّ هذه الأرض المُباركة، سيكون فيها ابتلاءات الأنبياء، ولم تسلم من ابتلاءات الأنبياء. |
| وذلك فيه الانتهاء عن حديث سيدنا إبراهيم عليهما السلام، هُنا إشارةٌ في سورة الأنبياء إلى الأرض المُباركة، وكأنها فيها تلميحات إلى أنَّ هذه الأرض المُباركة، سيكون فيها ابتلاءات الأنبياء، ولم تسلم من ابتلاءات الأنبياء. |
أرض الشام أرضٌ مُباركة ببركة الأقصى:
الدكتور بلال نور الدين:
| صحيح (الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) هي هذه الأرض المُباركة التي أكرمنا الله تعالى بالعيش فيها، وأصلُ بركتها هو المسجد الأقصى، وفلسطين المُباركة الطيَّبة وما حول المسجد الأقصى، كما قال كثيرٌ من المُفسّرين، فنحن نعيش ببركة هذه الأرض، أرض الشام أرضٌ مُباركة ببركة الأقصى، فهذه البركة التي حصلت لها لم تحصل هبةً مُجرَّدة عن ابتلاء، هذه سُنَّة الحياة، هذه الأرض تتعرَّض اليوم وتعرَّضت سابقاً، لحملاتٍ كثيرة من أجل النَيل من صمودها وثباتها وقوتها، لكن يأتي دائماً إن شاء الله بعد الثبات والقوة والمواجهة، يأتي بعد ذلك إن شاء الله التمكين والفَرَج، كما حصل مع أنبياء الله تعالى، وهذه إشارةٌ جميلةٌ جداً. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| وبعد هذا المشهد العظيم، نذهب مع الآيات لصبر الألف عام: |
وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(76)(سورة الأنبياء)
| دعوةٌ امتدَّت قروناً لم تفقد حرارتها، دعا، بكى، صَبَر، حتى جاءه الفَرَج بكلمةٍ واحدة: (فَاسْتَجَبْنَا) نرجو بيان أنوار عدم استبطاء الإجابة، فإنها تحين بعد تمام البلاء والصبر تفضل. |
الزمن عند الله تعالى ليس كالزمن عندنا:
الدكتور بلال نور الدين:
| قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أيضاً جاءت في آيتين اثنتين في هذه السورة، كما تفضَّلتم: (وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ) والفاء هُنا تلفِت النظر: (فَاسْتَجَبْنَا) الفاء في اللغة للترتيب على التعقيب، وكأنَّ الإجابة جاءت عقب النداء، نادى فاستجبنا (فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) لكن لو نظر الإنسان كما تفضَّلتم في سورة نوح، وجدَ أنه دعا قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً، فكيف يقول الله تعالى: (نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا)؟ لأنَّ الزمن عند الله تعالى ليس كالزمن عندنا، نحن نستبطئ، نحن نستأخر الإجابة، نحن نظن أنَّ الوقت قد طال، نحن نظن أن الابتلاء قد طال أمده، لكن في الحقيقة عند ربِّنا كُن فيكون، فالزمن مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى، يحكمنا لكنه لا يحكُم الله تعالى حاشاه، فربُّنا جلَّ جلاله يُبيِّن بقوله: (فَاسْتَجَبْنَا) أنَّ الإجابة مهما طال أمدُها فهي قريبة: |
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا(6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا(7)(سورة المعارج)
| الله تعالى قد يؤخِّر الإجابة بالنسبة لنا، نحن نستبطئُها، لكن هو في الحقيقة لمّا سيدنا موسى وهارون عليهما السلام: |
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ(89)(سورة يونس)
| أصبحت من الماضي أُجيبت، متى أُجيبت؟ بعد أربعين سنة، لكن قد أُجيبت وانتهى، فنحن ينبغي أن نستيقن هذا الأمر عندما ندعو الله تعالى، أنا بمجرد أن أقول يا ربّ، قد أُجيبت دعوتي انتهى، الآن متى يأتي موعد التنفيذ؟ هذا علمها عند ربّي لحكمةٍ بالغةٍ من الله تعالى، علمتُها أم جهلتُها، لأنَّ الله تعالى مُربّي، ما معنى ربُّ العالمين؟ مُربّي، الابن يقول لأبيه: يا أبتي أُريد حاسوباً، أُريد جوالاً، أُريد دراجةً هوائية، الأب يُحب ابنه، من اللحظة التي يطلب يقول أُريد أن آتيه بها، لكن الأب يقول: الجوال الآن مُضر لا ينفع، الآن أنت في مرحلةٍ دراسية، يؤجله له إلى حين يأخذ الشهادة ثم يأتيه به، لكن الأب من لحظة طلب الابن وضع في باله أنه سيأتي له بما أراد لأنه يُحبُّه، والله تعالى يُحبُّنا وهو ربُّ العالمين، كيف يُربّينا؟ من تربيته لنا أن يُحدِّد وقت العطاء وأن يُحدِّد وقت المنع، فإذا علم العبد الحكمة في المنع، صار المنع عين العطاء، فربُّنا جلَّ جلاله يُجيب الدعاء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: |
{ ما مِن رجلٍ يَدعو اللَّهَ بدعاءٍ إلَّا استُجيبَ لَهُ، فإمَّا أن يعجَّلَ له في الدُّنيا، وإمَّا أن يُدَّخرَ لَهُ في الآخرةِ، وإمَّا أن يُكَفَّرَ عنهُ من ذنوبِهِ بقدرِ ما دعا، ما لم يَدعُ بإثمٍ أو قَطيعةِ رحمٍ أو يستعجِلْ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَكَيفَ يستَعجلُ؟ قالَ: يقولُ: دعوتُ ربِّي فما استجابَ لي }
(أخرجه مسلم والترمذي وأحمد)
استبطاء الإجابة مانعٌ من موانع الإجابة:
| فلنعلَم أنَّ استبطاء الإجابة مانعٌ من موانع الإجابة، فندعو ونعلَم أنَّ الله حكيمٌ وعليم، يختار ما يُصلِحنا وقد أجاب دعوتنا، لذلك هذا هو الدرس: |
وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ(76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ(77)(سورة الأنبياء)
| فالنصر حاصل والاستجابة حاصلة، لا ينبغي أن نستبطئها، وإنما ينبغي أن نُعدّ أنفسنا لنكون أهلاً للدعاء لله وأهلاً لإجابة الله لنا. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم يا دكتور، ونحن نتحدَّث عن هذه الابتلاءات، وتجري بنا الآيات، ونحن على ظهر سفينة الابتلاءات، يأتي الحديث عن سيدنا داوود وسيدنا سليمان عليهما السلام، مثال العدل وفهم القلوب، قصة زرعٍ مأكول، حُكمٌ بليغ وفَهمٌ أبلغ، فهَّم الله سليمان وأثنى على كِلا الحُكمين، نرجو البيان والتوضيح بارك الله بكم يا دكتور. |
الدكتور بلال نور الدين:
| بعد قصة سيدنا نوح تأتي قصة سيدنا داوود وسيدنا سليمان عليهما السلام. |
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ(78)(سورة الأنبياء)
عندما لا يكون في شرعنا نَصٌ واضح في مسألةٍ ما فالاجتهاد فيها مطلوب:
| حتى يعلم المشاهدون عمّا نتحدَّث، نتحدَّث عن زرعٍ لرجُلٍ في مزرعة يعتني به، ورجُلٌ آخر عنده غنم والغنم في الليل (نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) عدَت في الليل على الزرع وأكلته، أفسدت الغنم الزرع، فالآن نحن بحاجة إلى حُكمٍ شرعي ماذا نفعل؟ هذا الرجُل أكلت غنمه على زرع جاره، فكان أن حكم داوود بحُكمٍ وحكم سليمان بحكمٍ أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحق، فكما روت الروايات أنَّ داوود حكم بأنَّ صاحب الزرع يأخذ الغنم دائماً، بينما سليمان قال: بل يأخذه حتى يُصلِح أرضه، فإذا صلحت أرضه رجعت الغنم إلى صاحبها، فهما حُكمان اجتهاديان، المسألة كما يُقال عندنا في شرعنا عندما لا يكون فيها نَصٌ واضح، فالاجتهاد فيها مطلوب، فيجتهد الإنسان بما يوافق العدل، بما يوافق الإحسان أحياناً، لأنَّ الله يأمُر بالعدل ويأمُر بالإحسان، فالإحسان مرتبةٌ فوق العدل، فهُنا أصبح هناك اجتهادان، الله تعالى أثنى على الاجتهادين (إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ) ما ذمَّ أحدهما (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) الله شهد وما غاب عنه لا حُكم داوود ولا حُكم سليمان، لكن أحياناً ربُّنا عزَّ وجل قال: |
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(76)(سورة يوسف)
| فالعِلمُ درجات، وليس كل عِلمٍ بمرتبة العِلم الآخر، فأحياناً يكون اجتهادٌ أقوى من الاجتهاد الآخر، فقال تعالى: |
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ(79)(سورة الأنبياء)
| فعلم داوود لا يُنكَر وحُكمه لا يُنكَر، لكن لعلَّ الله عزَّ وجل في هذه المسألة، أنار قلب سليمان بالحُكم الأقرب إلى الصواب، وهنا لمّا قال: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) ليعلم الإنسان أن توفيقه من الله تعالى وحده، فنحن لا نتحرك بقوتنا الذاتية وإنما بقوة الله، ولا نحكُم باجتهاداتنا الجيدة والقوية، بخبرتنا العميقة كما يحلو للناس، أنا قاضي مضى عليَّ كذا وكذا وأنا أحكُم، أنا لا أُخطئ، وإنما قال: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) فالله تعالى هو الذي يُفهَّمنا وهو الذي يُعلِّمنا، فيكون الحُكم ربما أَولى من حُكمٍ آخر، ثم بعد ذلك يذكُر ربُّنا جلَّ جلاله ما آتاه لداوود وما آتاه لسليمان، ويلفِت نظري في الحديث عن داوود قال: |
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ(80)(سورة الأنبياء)
(وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ) هذا عنوانٌ عريض اليوم لشبابنا وللناس :
| فالله تعالى هُنا يشير إلى أهمية العمل، إلى أهمية الكسب، ويُثني على الحرفة، سيدنا داوود يخيط الثياب ويخيط الدروع التي تُحصِن الإنسان من البأس (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ) هذا عنوانٌ عريض اليوم لشبابنا وللناس، بأن يتعلَّم الإنسان صنعةً تُعينهُ على حياته، وعنوانٌ لنا أيضاً في حياتنا وفي دولنا، بأنَّ الصنعة مطلوبة، والحرفة مطلوبة، اليوم هناك تعليمٌ مهني، فكما أننا بحاجةٍ إلى الأكاديميين، أيضاً بحاجةٍ إلى الصنعة التي تبني وتنهض بالأُمم، وتحدَّث ربُّنا جلَّ جلاله بعد ذلك، عن ما سخَّره لسليمان من الريح التي تجري بأمره، أيضاً إلى الأرض التي باركنا فيها، إعادة لذكر البركة في هذه الأرض الطيِّبة، وما يمكن أن يُحقِّقه الله من معجزاتٍ فيها، بنصر المؤمنين وخُذلان الكافرين، وعدم تحقيق أهدافهم إن شاء الله مما يريدونه، وما سخَّره الله له من الجن الذين كانوا يعملون بأمره. |
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ(82)(سورة الأنبياء)
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم، إذاً ذكر الأرض المُباركة في سورة الأنبياء أن يأتي مرتين، هذا لم يأتِ بالسياق العادي وإنما له مدلولات، له أنوار، له ألطاف، حينما يتحدَّث عن سليمان وعن الأرض المُباركة، حين يتحدَّث عن لوط وعن إبراهيم وعن الأرض المُباركة، عليهم الصلاة والسلام جميعاً، إذاً هنالك إشارات وهنالك توجه إلى هذه الأرض كما ذكرت في البداية، وإلى الابتلاءات التي ستكون عليها، بارك الله بكم. |
| الآن ننتقل للحديث عن الجسد النحيل يا دكتور، أهلٌ ذهبوا ولكن قلباً بقيَ يقول: |
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(83)(سورة الأنبياء)
| فكان الرد: |
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ(84)(سورة الأنبياء)
| حدِّثنا عن سيدنا أيوب عليه السلام، عن صبره الطويل، مع أنَّ ذكره في القرآن الكريم لم يتعدَّ الأربع مرات، في سورة ص، والنساء، والأنعام، وهُنا في الأنبياء، تفضل. |
الصبر مطيةٌ لا تكبو توصل الإنسان إلى أعلى الدرجات:
الدكتور بلال نور الدين:
| بعد أن ذَكَر الله عزَّ وجل سيدنا داوود وسيدنا سليمان، تحدَّث أيضاً بعُجالةٍ عن سيدنا أيوب، وأيوب معروفٌ بصبره، كما يُعرَف حاتمٌ بكرمه مع بُعد التشبيه وغير ذلك، فإذا ذُكِر أيوب ذُكِر الصبر، وقال تعالى: |
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ(44)(سورة ص)
| ما أجمل أن يجدنا الله صابرين، الصبر مطيةٌ لا تكبو، والصبر طريقٌ إلى الله عزَّ وجل، وصول الإنسان فيه حتميّ، فالصبر يوصِل الإنسان إلى أعلى الدرجات: |
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ(10)(سورة الزمر)
| فأيوب عليه السلام صحيح أنه لم يُذكَر كثيراً في كتاب الله تعالى، ولكنه أصبح رمزاً للرجُل الذي يُصيبه المرض أو الضُّر، فيلتجئ إلى الله تعالى بأدبٍ عالٍ جداً، قال: |
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ(83)(سورة الأنبياء)
| لم يشتكِ للخلق، يُعاب على المؤمن أن يشكو الخالق لخلقه، لا يفعلها المؤمن، قد يتخذ الأسباب، يقول أنا مريض من أجل أن يُعالجه الطبيب، لكن أن يتشكَّى ويتسخَّط أمام الناس وكأنه يشكو خالقه فالمؤمن لا يفعل هذا. |
| (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) لأنَّ الأصل هو الخير، قال: (مَسَّنِيَ) انظروا إلى هذا الأدب! ما قال أغرقني الضُّر وأصبحت فيه، وكأنه مسٌّ خفيف (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فنادى ربَّه ولم يُنادِ غيره، فجاءت الاستجابة كما جاءت لغيره من الأنبياء قال: |
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ(84)(سورة الأنبياء)
| فأيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو أيوب الصابر الذي بلغ مرتبةً عاليةً جداً من معرفة الله تعالى، هيأته لأن يصبر لحُكم الله تعالى، في كتاب الله تعالى يقول ربُّنا: |
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ(48)(سورة القلم)
| إذاً حُكم الله تعالى قد يأتي مُخالفاً لِمَا أُريده، لِما أطمح إليه، لِمَا أتمناه، وإلا لماذا أؤمر بالصبر؟ يعني لو كنت أُريد المال فالمال معي، وأُريد الزوجة فالزوجة معي، وأُريد الولد فالأولاد موجودون، وأُريد الصحة فالصحة قائمة، إذاً لماذا أُخاطَب؟ (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) إذاً حُكم ربّي قد يأتي بخلاف ما أُريده وبخلاف ما أطمح إليه، لكن الله أعلم، وأحكم، فأنا أصبُر لحُكم ربّي أي أحبس النفسَ عن الجَزع، والسخط، والتشكي، وأرضى بما قضاه الله تعالى لي، هذا معنى (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ). |
| في القرآن الكريم ثلاث مرات يقول تعالى: |
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60)(سورة الروم)
| فقط انتظر، أنت مهمتك أن تنتظر لكن الوعد حقّ، فهُنا أيوب يُعلِّمنا هذا الدرس العظيم في الصبر على الضُّر، والالتجاء إلى الله تعالى عند المصيبة، فيستجيب الله تعالى لعبده ويكشف ما به من ضُرّ. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| إذاً هذه الآيات تتحدث عن أدب الدعاء في بلاء الطُهر، والمقصِد هنا أنه إذا اشتدَّ الوجع يا دكتور فاعلم أنَّ أرحم الراحمين يسمعك، لا تشتكِ بل ارمِ قلبك على مكان وعتبة سجودك، بارك الله بكم. |
| ونذهب الآن إلى مشهدٍ سريع، وذكرٍ سريع لكنه شريف، لا تفاصيل بل صفةٌ واحدة تكفي: |
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ(85)(سورة الأنبياء)
| نحن هُنا نتحدَّث عن سيدنا إسماعيل وإدريس وذو الكفل عليهم السلام، لِما كانت هذه الآيات تتحدث فقط عن صدقٍ وتكليف؟ ما جماليات هذه الآيات التي تتحدث فيها عن هؤلاء الأنبياء يا دكتور. |
يُذكَر الإنسان بأفضل أعماله بعد موته:
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم كما تفضَّلتم هو سطرٌ واحد ذكر ثلاثة أنبياء: (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ) إذاً ماذا تريد أن تعرف عن هؤلاء؟ قال: (كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ) هُنا السورة أجملت، وفي مكانٍ آخر فصّلت، مثلاً نبي الله إدريس المعلومات عنه قليلة، ذو الكفل نبيٌ من أنبياء الله على قول جمهور المُفسّرين، وهذا الصحيح لأنَّ ذكره جاء بين الأنبياء، فليس مجرد رجُلٍ صالح وإنما هو نبيٌ من الأنبياء، ولم يُذكَر تفاصيلٌ عنه إلا أنه صابر، يعني أحياناً الإنسان يعيش حياته ويقضي إلى الله تعالى، ثم إذا ذُكِر بعد خمسين سنةٍ من وفاته، يُذكَر بفضلٍ له، يعني قد يقول الناس: فلان رحمه الله كان قارئاً للقرآن، كان حافظاً لكتاب الله، كان مُحسناً يتبرع للفقراء، كان يكفل يتيماً، وحياته كلها فيها: ذهبَ، ورجعَ، ودرسَ، وأكلَ، وشَرِبَ، وتنزَّه، لا تُذكر، يُقال بكلمةٍ واحدة فلان كان صابراً، فلان كان مُحسناً، فيُذكَر الإنسان بأجمل أعماله، وأفضل أعماله، فهُنا في سطرٍ واحدٍ ذكَرَ الله إسماعيل ونحن نعرف إسماعيل عليه السلام، ونعرف صبره، وأعظم صبره: |
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ(102)(سورة الصافات)
| وضع جبينه، ووضع رأسه، وقال له: اذبح يا أبي، ووضِعت السكين على الرقبة ولم يتحرك! لَمْ يَنْبَسْ بِبِنْت شَفَة، ولم يتسخَّط، ولم يشكُ! فنعرف صبره. |
| إذاً ما هو صبر إدريس وذا الكفل؟ يكفي أنَّ الله تعالى قال: (كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ)، فهذه شهادةٌ عظيمةٌ جداً يُذكَر بها الإنسان، الإنسان لن يُذكَر بعد موته بشهاداته العُليا على أهميتها، ولا بمكانته التي بلغها، ولا بالوزارة التي تقلَّدها، سيُذكَر بعمله فقط، بصبره، بجهاده، بثباته، بمساعدته للناس، بإحسانه للآخرين، بصلاته، بعبادته، هذا ما يُذكَر اليوم بين الناس، فربُّنا جلَّ جلاله قال: (كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ) فأعطاهم شهادةً في الصبر، يعني ليتنا جميعاً يجدنا الله تعالى من الصابرين ونأخذ هذه الشهادة العظيمة. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| اللهم آمين، إذاً يا دكتور بشكلٍ عام، الصدق والتكليف يفردان جناحيهما على هذه القصص وعلى هؤلاء الأنبياء، ليس شرطاً أن تُروى قصتك مراراً، ولكن يكفي أن يعلم الله صدقك، وثباتك، وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. |
الدكتور بلال نور الدين:
| فإذا علم الله من الإنسان الصدق، قال: |
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ(86)(سورة الأنبياء)
| يأتي الإكرام من الله جلَّ جلاله. |
المحاورة هناء المجالي:
| لا إله إلا الله، وإذا ما ذهبنا إلى التسبيح والذِكر يا دكتور، والذي ذُكِر في القرآن كثيراً وكان صفةً لازمة لكلِّ نبي، لكن هنا نتحدث عن تسبيحٍ مختلف، عن تسبيح يونس عليه السلام في بطن الظُلمات، وتسبيح زكريا عليهما السلام، ماذا تُحدِّثنا عن هذه المشاهد، وهذا الإعجاز البلاغي والتصوير البياني تفضل. |
المؤمن إذا ناجى ربّه وطلب منه فإنَّ الله يُنجيه من الغم ويكشف كربه:
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم بعد ذلك يذكُر الله تعالى كما تفضَّلتم نبيَّيه يونس وزكريا عليهما السلام، ويشتركان كما تفضَّلتم بشيءٍ واحدٍ وهو تسبيح وذكر الله تعالى، والناتج عنه: |
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ(88)(سورة الأنبياء)
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(90)(سورة الأنبياء)
|
في الحالتين: في الأولى: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ) والثانية: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ) فهُنا عندما نتأمل في هذه الآيات الكريمة، يونس عليه السلام: |
وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ(87)(سورة الأنبياء)
| لم يهتدِ قومه، لم يستجيبوا، لم يسمعوا، والإنسان بطبيعته يُحب أن يرى أثر عمله، ويونس قضى فيهم عُمراً ولم يستجيبوا (فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ) أي لن نُضيَّق عليه، وليس لن نقدر بمعنى من القدرة حاشاه، أن يعتقد أنَّ الله لا يقدر عليه، هذه لا تليق بمؤمنٍ فكيف تليق بنبي؟! يعني فظنَّ أن لن نُضيَّق عليه في الأمر، ففيه سَعة فليذهب فذهب، لكن هذا لا ينبغي للداعية أن يترك موقعه، للمُصلح أن يترك مكانه مهما طال أمد الاستجابة، فحصل ما كان: |
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142)(سورة الصافات)
| (فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ) في ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر. |
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ(40)(سورة النور)
| (أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) وهُنا قال العلماء هذا دعاء، الذكر دعاء، هو ما قال: أسألك أن تُفرِّج عنّي، لكن يكفي أنه قال: (لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) اعترف بظلم نفسه وناجى الله تعالى، قال: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ). |
| هُنا أُريد أن أؤكد على موضوع قال: (وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ) انتهت القصة هُنا، قال: (وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) حوَّلها من حالةٍ فردية إلى قانونٍ جماعي، حتى لا نقرأ القرآن بنَفَسٍ أنه تاريخ، لا أبداً، القضية قضية قانون إن صحَّ التعبير بالعُرف الحديث، سُنَّة من سُنَن الله تعالى بالعُرف القرآني (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ) وهذه له وحده؟ قال: (وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) إلى قيام الساعة، فهو قانونٌ يشملك كما شملَ أنبياء الله، ليس للأنبياء فقط، أنت أيضاً إذا ذكرت الله وناجيته وطلبت منه، فإنَّ الله يُنجّيك من الغمِّ الذي أنت فيه، يكشف الكُربات، ويُدخِل إلى قلبك السكينة، ويُبعِد عنك الأذى (وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ). |
| الآن مُشابه له زكريا عليه السلام، زكريا له قصةٌ أُخرى لم يقع في غمٍّ، أو يدخُل في بطن الحوت، أو في الظُلمات، لكن: |
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ(89)(سورة الأنبياء)
| زكريا يريد الولد، يريد من ينفع الناس من بعده، يريد من يبقى، لأنَّ الإنسان في طبيعته عنده حاجات، من حاجاته الطعام والشراب لبقاء الجنس، ومن حاجاته الزواج لبقاء النوع، ومن حاجاته تأكيد الذات لبقاء الذِكْر، يُحب أن يبقى ذِكره، قال: (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) فيُحب الولد، فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ). |
| فهُنا سيدنا زكريا عليه السلام، طلب طلباً من الله عزَّ وجل، وهو أن يرزقه الولد، فكان أن قدَّر الله له ذلك ووهبه، ولا يخفانا في قوله تعالى: (وَوَهَبْنَا) أنَّ الولد هِبةٌ من الله تعالى، وعطيةٌ عُظمى ينبغي أن يرعاها الإنسان، وأن يقوم على تربيتها وتنشئتها التنشئة الصالحة التي تُرضي الله. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم يا دكتور، وفي آخر المشاهد مشهد الطُهر والنقاء، مشهد الاصطفاء، ظهرت آيةٌ خالدة: |
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ(91)(سورة الأنبياء)
| ماذا تُحدِّثنا يا دكتور عن طهارة السيدة مريم عليها السلام؟ عن الصمت في وقتٍ بحاجةٍ للدفاع عن النفس، ماذا تُحدّثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد؟ ولِمَ بعد الحديث عن كل هؤلاء الأنبياء تأتي الآية الكريمة: |
إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ(92)(سورة الأنبياء)
| تفضل. |
عندما تكون صاحب حقّ ومظلوم فإن الله يتولى أمرك ويتولى بيان الحقّ:
الدكتور بلال نور الدين:
| خُتِم الحديث عن الأنبياء بذكر مريم عليها السلام، وابنها النبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والله تعالى هُنا الخطاب عام لكنه يخُصّ النساء أكثر، فما أجمل الحياء وما أشدَّ جماله في النساء، وما أجمل الطُهر والعفاف، وما أعظم جماله وطُهره وعفافه في النساء، فهذه المرأة الصالحة حصَّنت نفسها من الحرام، وأبعدت نفسها عن ما يُشينها في الدنيا والآخرة، وحمت نفسها من كل معصيةٍ، فكان أنَّ الله تعالى قال: (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا) انظروا إلى العطاء الذي يُكرم الله تعالى به المرأة الحيَّية، الستيّرة، العفيفة، الطاهرة، ولننظُر إلى أثره، فما الذي حصل؟ الله تعالى جلَّ جلاله عبر جبريل عليه السلام قال: (فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا) فكان أن كان لها هذا الولد العظيم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام (وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ). |
| وانظروا إلى ما تفضَّلتِ به حضرتك أنه الصمت: |
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا(26)(سورة مريم)
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29)(سورة مريم)
| كيف ربُّنا عزَّ وجل يُربّي النفس الإنسانية، على أنك عندما تكون صاحب حقّ ومظلوم، فإنَّ الله عزَّ وجل يتولى أمرك، وإنَّ الله عزَّ وجل يتولى بيان الحقّ، وإن الله عزَّ وجل يتولاك. |
| طبعاً الإنسان يدافع عن نفسه، لكن السيدة مريم كانت في موقفٍ ليس فيه دفاع، يعني لماذا تدافع عن نفسها؟! |
فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا(22)
| يعني التهمة واضحة والبراءة منها تكاد تكون شبه معدومة أمام الناس، لكن الله عزَّ وجل في عليائه تولَّى الدفاع عنها لأنها طهَّرت نفسها، وحصَّنت نفسها من الآثام ومن المعاصي، فكافأها الله تعالى بهذه المكافأة العظيمة، ولا يخفى في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ) هذه إشارةٌ إلى نبي الله عيسى عليه السلام. |
رسالة الأنبياء جميعاً التوحيد والعبادة:
| ثم يقول تعالى: (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) هذا فيه إشارة إلى وحدة الأنبياء، ووحدة الدعوة التي جاء بها الأنبياء: |
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ(25)(سورة الأنبياء)
| فكل الأنبياء جاؤوا بشيئين اثنين، جاؤوا بالتوحيد وبالعبادة، التوحيد قمة العِلم والعبادة قمة العمل، الإنسان نشاطه في الحياة علمٌ وعمل، إمّا أن أكون أتعلَّم أو أعمل، ما قمة العِلم؟ التوحيد، فلو تعلَّم الإنسان كل علوم الدنيا ولم يتعلَّم التوحيد فقد خاب وخسر، ولو جهل كل علوم الدنيا مع أهميتها لكنه تعلَّم التوحيد فقد أفلح، ما نهاية العمل؟ أنا أعمل، أذهب، أرجع، أنزل إلى السوق، أنزل إلى الجامعة، ما نهاية وقمة العمل؟ أن أكون في عبادة الله تعالى، والله تعالى ما أرسل من نبيٍ إلا ليُعلِّم الناس شيئين العِلم والعمل، التوحيد والعبادة (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا) حُسن التوجه إلى الله، التوحيد (فَاعْبُدُونِ) العمل، عبادةٌ لله تعالى، نجعل أعمالنا في طاعة الله تعالى. |
| فلذلك خُتمت هذه القصص بخاتمةٍ رائعةٍ جداً (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) نحن جميعاً إخوة، أنبياء الله إخوة وأتباعهم إخوة، فأتباع عيسى إخوتنا، وأتباع موسى إخوتنا، وأتباع إبراهيم الذي كان حنيفاً مسلماً إخوتنا (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) كلها على مبدأ التوحيد والتوجُّه إلى الله، وحُسن العبادة لله تعالى (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) إلهنا واحد وأنبياؤنا متعددون لكنهم يدعون إلى إلهٍ واحد وإلى عبادة إلهٍ واحد. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم، ولكن الآية التي تتبعها كان فيها جمالية جداً تخفى على كثيرٍ من الناس، إلا من تدبَّر ووعى هذه الآية يا دكتور: |
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ(93)(سورة الأنبياء)
| إذاً بعد كل هذا الحديث، بعد كل هذه الابتلاءات، بعد كل هذه القصص، وبعد توحيد الله يبقى البشر بشر، وعندهم هذه النزعات البشرية، فيصفها القرآن بأنهم بعد كل هذا التفصيل إلا أنهم: (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ) ولكن (كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) هذه جماليات تفصيلية مع كل هذا السرد، إلا أنَّ البشر ينسون، يتناسون، يذهبون في غفلات الحياة، ثم هُم يعودون إلى الله. |
الدين يجمع ولا يُفرِّق:
الدكتور بلال نور الدين:
| لأنَّ طبيعة البشر: |
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ(119)(سورة هود)
| طبيعة النفس البشرية أنها تُحب الاختلاف، أو لا أقول تُحب وإنما تسعى إليه، أو توجِد أسبابه، مع أنَّ الله تعالى لم يوجِد أسباب الخلاف في الدين، فالدين في الأصل يجمع ولا يُفرِّق، قال تعالى: |
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ(13)(سورة الشورى)
| فالدين يجمعنا لأنَّ القِبلة واحدة، ولأنَّ الإله واحد، ولأنَّ الأنبياء يدعون إلى دعوةٍ واحدة، ولأننا نقف في صلاةٍ واحدة، ولأننا، ولأننا.. ومع ذلك نجد كما قال تعالى: |
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ(14)(سورة الشورى)
| فتجد أنَّ الناس يتفرقون في دين الله تعالى، وهذا له أسبابه الكثيرة التي ليس الآن مقام ذكرها. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم: |
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ(23)(سورة الجاثية)
الدكتور بلال نور الدين:
| عندما يكون الهوى، وللأسف اليوم الهوى يلبس لبوساً مختلفة، فما أحد يقول لك: أنا أتبع هواي، اليوم يقول لك: أنا أتبَع عقلي، على سبيل المثال، يقول لك: قال لي عقلي، وأنا يقول لي عقلي شيئاً آخر بخلاف ما قاله لك عقلك، فإذا كان كل واحدٍ سيتبَع عقله فهو في الحقيقة سيتبَع هوى نفسه، فاليوم ليست تبعية العقل بمنأى عن تبعية الهوى، إذا لم تكن منضبطة بفهم النصوص والتعامل مع الوحي، فهذا له أسبابه كما قلنا، لكن ربُّنا جلَّ جلاله يختم بختامٍ رائعٍ قال: (كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) يعني في النتيجة العودة إلى الله تعالى وحده وهو الذي سيُحاسِب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثِر في سجوده من دعاء: |
{ اللَّهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ أنتَ تحكُمُ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيهِ يختلِفونَ اهدِني لما اختُلِفَ فيهِ منَ الحقِّ بإذنِكَ إنَّكَ تهدي من تشاءُ إلى صِراطٍ مستقيمٍ }
(أخرجه مسلم)
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم، لذلك يا دكتور نرى المِلل، نرى الطوائف، نرى الأفكار، لأنَّ كل إنسانٍ فينا اتخذ هواه هو إلهَهُ واتخذ تفكيره هو الحقّ، وأنني أرى، وأظنّ، وأشكّ، إذاً هذه كلها جاءت في مُحصِّلة (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم) هُنا يضيق ذكر هذه المعاني الجميلة، ولكن نُفرِد لها حلقة خاصة بإذن الله تعالى. |
الدكتور بلال نور الدين:
| إن شاء الله. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم، إذاً إخوتي الكرام في سورةٍ واحدة، اجتمع الأنبياء وكل واحدٍ منهم ترك أثراً خالداً، ودعوةً حيّة، وعبرةً لا تموت. |
| فيا مَن أثقله البلاء قفْ مع أيوب، ويا مَن غرق في ضيق النفس سَلِّم روحك مع يونس، ويا مَن استصعب التغيير تذكَّر نوحاً، ويا مَن سعى للتوحيد امشِ على خُطى إبراهيم عليهم السلام جميعاً. |
| فهذه ليست قصص بل مرايا للنفس، وخرائط للسالكين، ونفحات نبوةٍ في درب المتقين، وكل ذلك جُمِع في قلب المبعوث رحمةً للعالمين صلوات ربّي وسلامه عليه. |
| بهذا مُستمعينا نختم حلقة اليوم، وفي الختام نشكُر الضيف الكريم فضيلة الدكتور والعالِم الجليل الدكتور بلال نور الدين، ونشكُرك يا دكتور على ما قدَّمتم وأفدتم، وجُزيتم خير الجزاء. |
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم، وشكراً لهذه الاستضافة الطيِّبة، حيّاكم الله. |