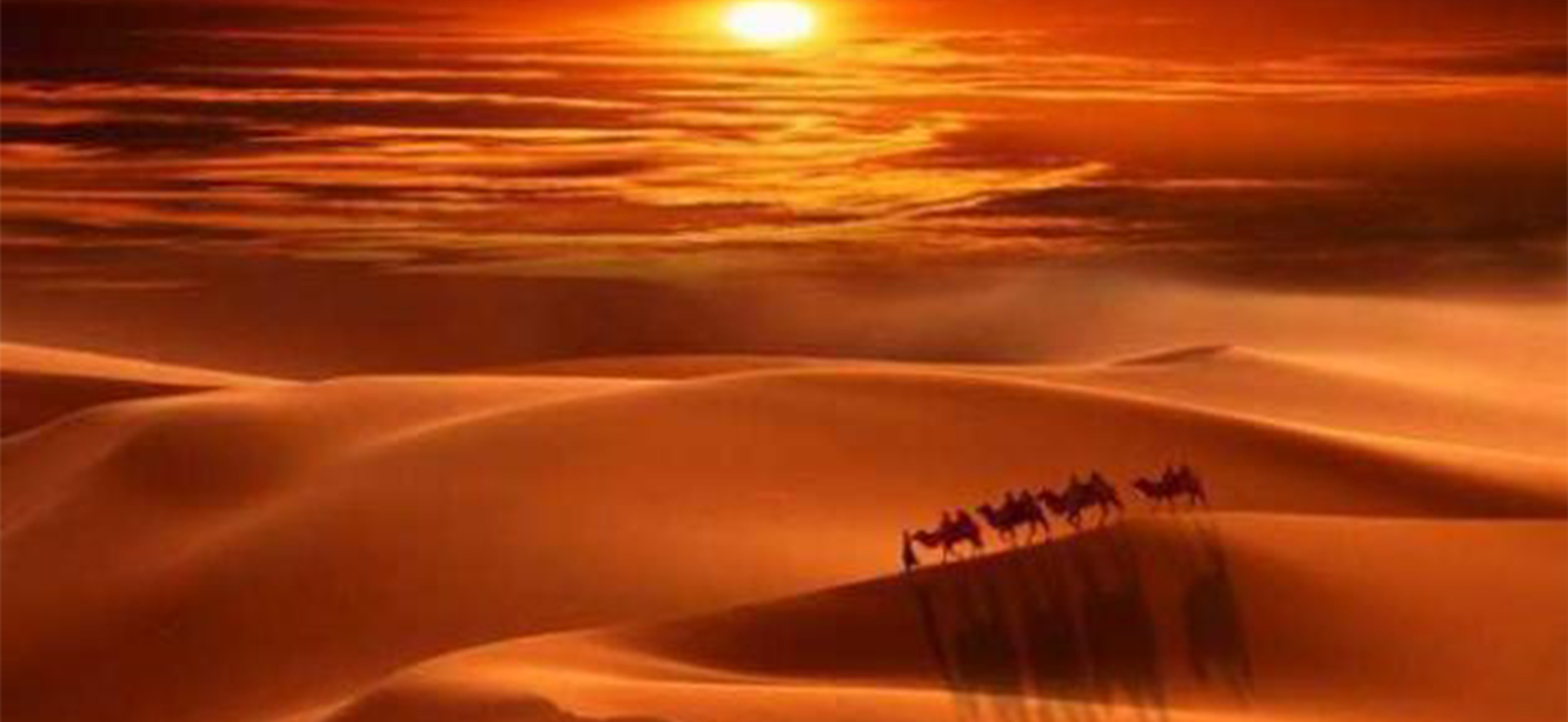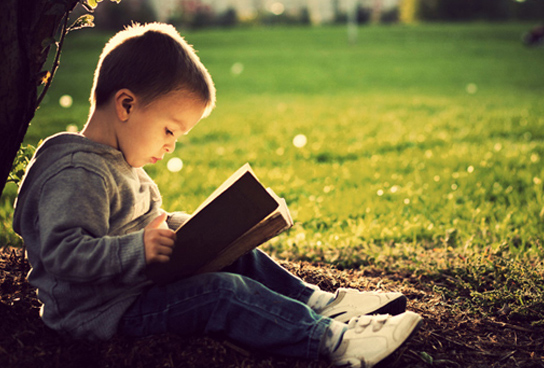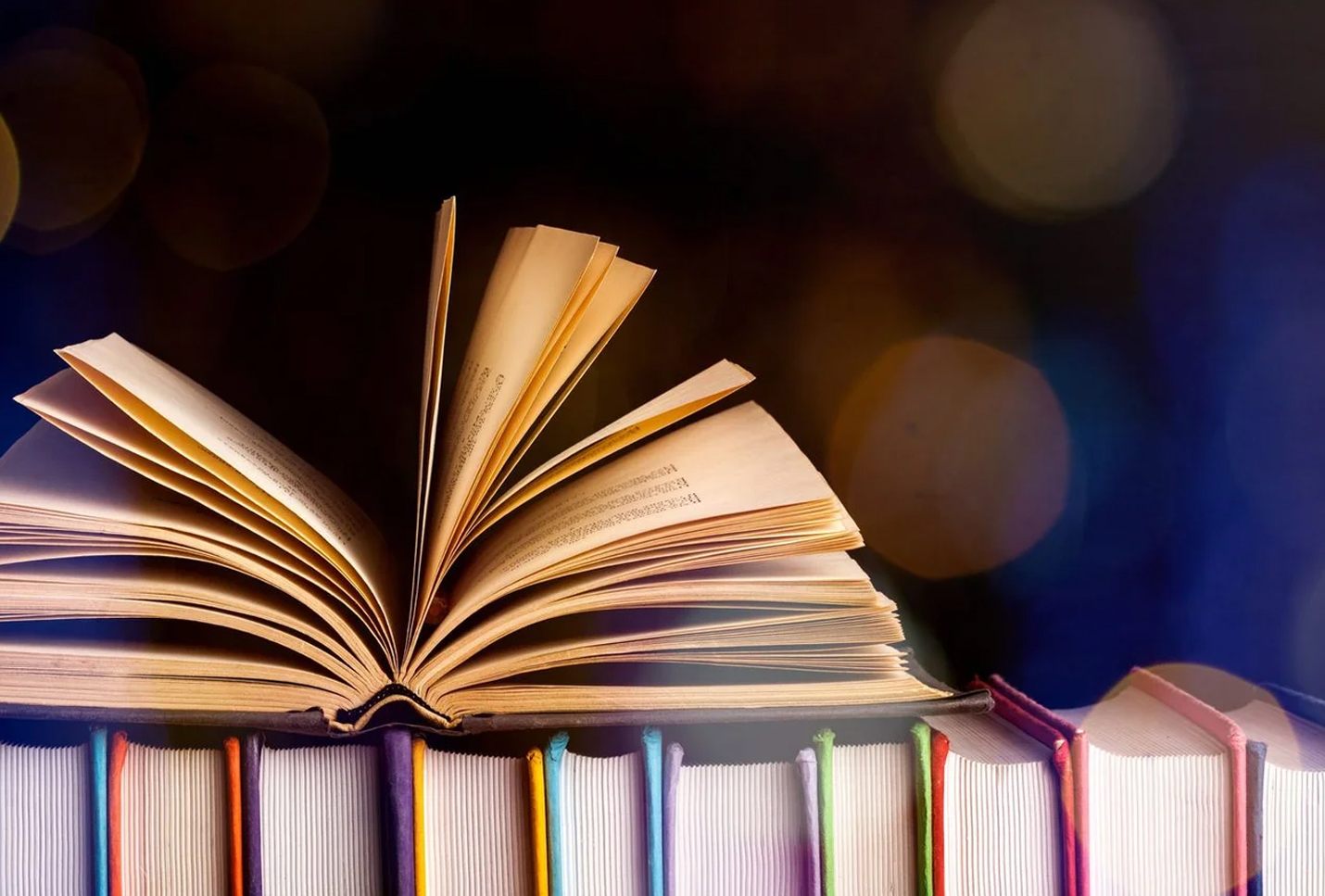الهجرة النبوية في ضوء سورة التوبة
الهجرة النبوية في ضوء سورة التوبة
مقدمة:
| إخوتي الكرام في كل عامٍ نستذكر الهجرة النبوية الشريفة، فنتذكر خُطى المُهاجرين على الرمال، ونسمَع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يودِّع الوطن، ونستشعر معاً التضحية والصدق والولاء، ولكن القرآن الكريم عرض الهجرة في سورةٍ عظيمة، لها نَفَسٌ قيادي ونبضٌ سياسي وميزان إيمان، إنها سورة التوبة، فهل سألنا أنفُسنا يوماً كيف نظر القرآن إلى الهجرة؟ وما مكانتها في سورة التوبة؟ تعالوا نخوض معاً في هذه الحلقة المُباركة مستمعينا، بالعقل والقلب والقرآن، ويُسعدنا أن يكون معنا ضيفاً مُحاوراً فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير والإعجاز في القرآن الكريم، عضو رابطة علماء الشام والمدير والمُشرف العام على الموقع الرسمي لفضيلة العالم الجليل الدكتور محمد راتب النابلسي. |
| حيَّاكم الله دكتور وكل عامٍ وأنتم بخير. |
الدكتور بلال نور الدين:
| حيَّاكم الله، بارك الله بكم، وكل عامٍ وأنتم وجميع المُستمعين إن شاء الله بألف ألف خير. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| اللهم آمين، دكتور بلال اليوم ونحن في ظلال سنةٍ هجريةٍ جديدة، لعلَّنا نقف مع سورة التوبة، نسبُر فيها أعماق الهجرة النبوية، نقف معاً على أبعادٍ قلَّ من يلتفت إليها، معانٍ تفوق كون الهجرة تاريخاً يُذكَر لنجعلها قضيةً تُعاش، لذلك أبدأ الحوار دكتور بلال بالحديث عن بدايات سورة التوبة، هذه السورة بدأت بلا بسملة لا تُجامل أحد، وفي مقدمتها براءة. |
| السؤال: هل نستطيع القول أنَّ سورة التوبة إعلانٌ رسمي لأثر الهجرة في بناء دولة الإسلام مثلاً؟ هل نستطيع أن نَصِفْ الهجرة في سورة التوبة ونُحدِّد هل هي نداءٌ إيماني أو موقفٌ سياسي؟ نرجو التوضيح بارك الله بكم. |
الدكتور بلال نور الدين:
| حيَّاكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وبعد. |
الهجرة موقفٌ مُستمر وليست حَدثاً طارئاً:
| شكراً لطرح هذا الموضوع المُهم، الحقيقة أنَّ سورة التوبة كما تعلمون نزلت في السنة التاسعة للهجرة، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، لكن ذَكرَتْ الهجرة في ثناياها بشكلٍ واضح، لعلَّ في ذلك دلالةً واضحة على أثر الهجرة في بناء دولة الإسلام كما تفضَّلتم في سؤالكم، بمعنى أنَّ الهجرة ليست موقفاً عرضياً اقتضته حالةٌ طارئة، كان المسلمون يسامون سوء العذاب في مكة، فجاءت الهجرة خروجاً وفراراً بالدين والأهل، وتركاً للوطن وما فيه من ما يُحبه الإنسان، إلى وطنٍ آخر، إلى دولةٍ جديدة أسَّسها النبي صلى الله عليه وسلم. |
| فقد يتصوَّر إنسانٌ أنَّ الهجرة هي موقفٌ طارئ حصل في فترةٍ وانتهى ولا رجعة له، فجاءت سورة التوبة بعد تسع سنواتٍ من الهجرة، لتُعيد التركيز على أهمية الهجرة على أنها موقفٌ مُستمر وليست حَدثاً طارئاً، لذلك عندما نقرأ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: |
{ المسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانهِ ويدهِ، والمهاجرُ من هجر ما نهى اللهُ عنه }
(أخرجه البخاري ومسلم)
| إذاً: الهجرة هي حركةٌ مدروسةٌ لتغيير الواقع نحو الأفضل، قد تعود في أي مكانٍ وفي أي زمان، في أي عصرٍ وفي أي مِصر، نضطر إلى الهجرة ونحن في أوطاننا، كم نهجر اليوم مواطن فيها السوء، فيها الوقوف مع الباطل، فيها تأييد الظالمين، كم نهجرها إلى مواطن أُخرى ننتصر فيها لديننا وللحقّ ولأهل الحقّ، كم نترك مجلساً فيه غيبة إلى مجلسٍ يُذكَر فيه اسم الله، كم نترك مجلساً فيه اختلاطٌ غير مُنضبط وفيه تعدٍّ على حُرمات الله، إلى مجلسٍ آخر ينضبط بمنهج الله تعالى، فجاءت سورة التوبة بعد تسع سنواتٍ من الهجرة، لتُعيد التأكيد على مفهوم الهجرة. |
أثر الهجرة في بناء دولة الإسلام:
| أولاً: أثر الهجرة في بناء دولة الإسلام، طبعاً سورة التوبة نزلت على مشارف غزوة تبوك، والمسلمون يستشرفون سَفَراً طويلاً، ومَشقَّةً شديدةً، وحرَّاً شديداً، وفيه من البلاء ما فيه، فجاءت سورة التوبة لتُبيِّن بداية التاريخ الإسلامي، بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة، ثم لتؤكد على أنَّ الهجرة ليست موقفاً طارئاً انقضى بانقضاء زمانه، وإنما هي حدثٌ مستمرٌ يعود في كل زمانٍ وفي كل مكان، فإمّا أن تترك وتُهاجر وإمّا أن تبقى في مكانك، الهجرة حركة، لذلك قالوا: ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن، حتى تُعبِّر عن ذاتها بحركةٍ نحو الخلق إحساناً، ونحو الخالق صلةً وإيماناً، أمّا مسلمٌ سكوني لا يوجد، مسلم يقول أنا مسلم، قال تعالى: |
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(72)(سورة الأنفال)
| أي بالمفهوم العام للهجرة مؤمن لا يتحرك ليس له ولاء للإسلام، الولاء للإسلام يقتضي أنك آمنت إذاً تحرَّك. |
| يعني بمثلٍ بسيطٍ مُنتزع من الواقع، رجُلٌ قال له الطبيب يجب أن تتعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة ساعتين من أجل مرضك الجلدي، فخرج من عند الطبيب شاكراً له، وبدأ يمدح الشمس ويمدح أهميتها ويمدح ما تُحقِّقه من شفاءٍ، لكنه بقي قابعاً في قبوٍ مُظلمٍ، إذاً لم تنتفع بضوء الشمس أبداً، الإسلام كضوء الشمس، فإذا آمنت لا بُدَّ أن تتحرك لنُصرة دينك هذه هي الهجرة، أن يتحرك الإنسان لنُصرة المبدأ الذي آمن به، أنت آمنت إذاً ينبغي أن تُهاجر في كل مكانٍ، في كل عصر، ليس الهجرة بمعنى الانتقال من مكانٍ إلى مكان، أحياناً يكون هناك هجرةٌ عكسية في سبيل الشيطان، يذهب إلى أماكنٍ لا ترضي الله، لكن الحمد لله بلادنا تقام فيها الصلوات، وتؤدَّى فيها الطاعات، وتُفتح فيها المساجد، وهذا من فضل الله ورحمته، لكن ينبغي أن تتحرك لنُصرة دينك، هذه هي الهجرة بمفهومها الحديث، لذلك جاءت في سورة التوبة بعد تسع سنواتٍ لتأكيد هذا المعنى المُهم. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم، إذاً دكتور جاءت هذه السورة كما قلت بعد الخطاب، بعد بناء دولة الإسلام في المدينة، ثم قوة المسلمين بعد عدة غزوات، وبعد نقض المشركين للعهود، فجاءت البراءةُ السياسة الشاملة، وجاء الخطاب العلني بأنَّ العهد القديم قد انتهى، بارك الله بكم ولكن عندما يأتي الخطاب من الله سبحانه في هذه السورة بقوله تعالى: |
إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(40)(سورة التوبة)
| في غار ثور يا دكتور كان الصاحبان، وقُرِئت عليهما آياتٌ تُتلى إلى اليوم، هذه الآية ماذا تقول للمسلم اليوم؟ ما هو المعيار الحقيقي لنُصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ |
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ) كما قلنا متى نزلت هذه الآيات؟ حتى نعرف السياق، هي في سورة التوبة كما تفضَّلتم، نزلت والمسلمون يستعدون لغزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يُخبِر الناس بوجهته فالحرب خُدعة، هذا من الناحية الإعلامية، التعتيم الإعلامي للخروج إلى مكان الحرب تعميةً على الأعداء، إلا في هذه الغزوة فالنبي وضَّح الوجهة، لأنَّ الطريق طويل، ولأنَّ السفَر شاق، ولأنَّ الحرّ شديد، والروم قد تجمَّعوا في أرض الشام، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم وجهته، الآن بدأ بعض المُرجفين، بعض المنافقين، بعض المُشكّكين، بعض ضعاف الإيمان، بدأوا بتثبيط الناس، لِمَ تخرجون؟ ماذا تفعلون؟ تلقون بأنفسكم إلى التهلكة، السفَر طويل، الحرّ شديد إلى آخره.. |
الله ناصرٌ دينه بكَ أو بغيرك:
| الآن خاطبهم الله تعالى قال: (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ) الرسالة الأولى من الآية أنَّ الله ناصرٌ دينه بكَ أو بغيرك، الدين مُنتصر، هذا دين الله لا نقلق على دين الله فهو منتصرٌ بنا أو بغيرنا، ولكن فلنقلق على أنفسنا نحن، هل نحن جنودٌ لخدمة الحقّ أم والعياذ بالله في تثبيط الناس عن الحقّ؟ لذلك نحن لا ننصُر الإسلام نحن ننتصر بالإسلام، نحن لا ننصُر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ننتصر به، نحن ينصرنا الإسلام وينصرنا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. |
| فالله عزَّ وجل هُنا أخرج الأمر من يدهم، قال: (إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ) النصر مُتحقِّق بكَ أو بغيرك، لكن انظر أين موقعك أنت، هل أنت في الخندق الصحيح أم في الخندق المُعادي؟ ثم قال تعالى: (فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ) أعادهم إلى البداية. |
| كان الإسلام كله في تلك اللحظة رجُلين اثنين، لم تكونوا كلكم، لم يكن أحدٌ منكم من هذه الألوف المؤلَّفة التي تستعد الآن لمواجهة الروم (ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) ورغم كل هذا الضعف، وليس هناك جيشٌ معه، وليس هناك قوةٌ تحميه، وقد جعلوا مئة ناقةٍ لمن يأتي به حيّاً أو ميّتاً، وهو مُطارد يقبَع في غار ثور، ووصلوا إلى الغار، في كل هذه الظروف التي ربما يُقال نسبة النجاة فيها لا تكاد تُذكَر، أو هي صفر بالمئة، في مثل هذه الظروف (فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ) أكَّدَ على (ثَانِيَ اثْنَيْنِ) أي لم يكن معه أحد، كما هو الحال اليوم، تظنون أنكم تنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! الله هو الذي نصره (ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ) فمن كان الله معه فلا شيء عليه، ومن كان الله عليه فلا شيء معه. |
| فإذاً هذه الآية توضِّح: |
| أولاً: لا تقلق على هذا الدين فالله ناصره بكَ أو بغيرك. |
| الحقيقة الثانية: نحن لا ننصُر رسول الله فحسب بل نحن ننتصر به. |
| والحقيقة الثالثة: أنَّ الله تعالى تولَّى نُصرته يوم كان وحيداً لا جيش معه (ثَانِيَ اثْنَيْنِ) فأنتَ يجب أن تُحدِّد موقعك في نُصرة الحقّ، وأن تضع نفسك في خدمة الحقّ وفي خدمة دين الله تعالى، وإيّاك أن تتصور أنك أنتَ مَن تنصُر، وإنما أنت مَن تكون في خدمة الحقّ وأهله، والله تعالى هو الذي ينصُر الحقّ وأهله، وهذا الكلام نوجهه اليوم لأهلنا في فلسطين، ولأهلنا في كل مكانٍ يُسامون فيه سوء العذاب، في هذه الذكرى التي تبعَث على التفاؤل، بأنَّ الله تعالى ناصرٌ دينه ومُظهِرٌ الحقّ، وناصرٌ المستضعفين، ولكن ربُّنا جلَّ جلاله قد يؤخِّر ذلك لحكمةٍ، ولكن لا بُدَّ أن ينتصر الحقُّ بأهله، ولا بُدَّ أن نكون نحن جنوداً إن شاء الله لنصرة هذا الدين. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| إذاً دكتور حسب ما تفضَّلت بالنسبة لسورة التوبة، هي لم تكتفِ بسرد الهجرة، بل جعلتها معيار للنُصرة والصُحبة والولاء، لذلك السورة وكما بيَّنتْ، هي بيَّنَتّ مَن أحبَّ الله وأحبَّ رسوله وكانت الهجرة إليهما، وأيضاً السورة فضَحَت كثيراً من المُعذّرين، فهل كانت الهجرة مِحكٍ يفصل بين صفاء الإيمان، نور الإيمان، وبين ظُلمة النفاق؟ هل يمكن القياس عليها في زمننا الحاضر يا دكتور؟ |
الهجرة هي الفاصل بين الإيمان والنفاق:
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم بارك الله بكم، كلمةٌ طيَّبةٌ جداً، الهجرة هي الفاصل بين الإيمان والنفاق، المنافق يدَّعي الإيمان لكنه غير قادر على تحمُّل التكاليف التي تترتب على الإيمان، بينما المؤمن يؤمن حقاً فهو مستعدٌ لأن يُضَّحي بنفسه وبوطنه وبكل ما يملِك، أقصِد بالوطن مقام إقامته وليس بالمفهوم العام، وإنما بالمكان الذي يجلس فيه، يُضَّحي بمكانه الذي يألفه ويعتاده من أجل نُصرة دين الله تعالى، ففي هذا المعنى كما أسلفنا قبل قليل، قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ) النبي صلى الله عليه وسلم يقول: |
{ سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ الهِجْرَةِ، فَقالَ: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا }
(صحيح مسلم)
| اليوم لو أنَّ إنساناً قال: سأُطبِّق مفهوم الهجرة، وهو يُقيم في مكَّة المُكرَّمة حماها الله، فوقف وركب الحافلة ووصل إلى المدينة، وقال: أنا هاجرت، نقول له: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ) ماذا تفعل؟! الحمد لله شرع الله يُقام في مكَّة وفي المدينة، ماذا بعد الفتح إذاً؟ قال: (ولَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) ما يزال باب الهجرة مفتوحاً لكن بالمعنى العام للهجرة وليس بالمعنى الضيِّق، وهو الانتقال من مكَّة إلى المدينة، لا يزال باب الهجرة مفتوحاً قال تعالى: |
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(97)(سورة النساء)
كيف يكون الاستضعاف في الأرض؟
| كيف يكون الاستضعاف في الأرض؟ الإنسان إمّا أن يُستضعف في الأرض، أن يكون في مكانٍ يُمنع فيه من أداء شعائر دينه، يُقال له ممنوع الصلاة، يُقال للمرأة ربما في بعض المدن أو البلاد يُمنع الحجاب في هذه المدينة، مُستضعفة (قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا) هناك معنى آخر للاستضعاف اليوم، يعيشه بعض أهلنا في بلاد الاغتراب، أو أحياناً في بلادنا لكن في مواطن الفِتن والسوء، يكون في شركةٍ مُعيَّنة أو في مكانٍ مُعيَّن تُنتهك فيه حُرمات الله، فيقول لك: أنا مُستضعف، هل يمنعك أحد؟ يقول: لا والله، لكن شدّة الشهوات التي حولي وكثرة الشُبهات تمنعني، فهو بحكم المُستضعف. |
| إمّا أن يكون الاستضعاف هو سياط الجلادين اللاذعة، أو أن يكون سبائك الذهب اللامعة، ففي الحالتين هناك استضعاف، إمّا أنَّ هناك أحداً والعياذ بالله يمنعني من أداء شعائر ديني، هذا استضعاف يجب أن أُهاجر، أن أترك المكان إلى مكانٍ آخر، أو أكون في مكانٍ يُسمح لي بأداء شعائر ديني، لكن كل ما حولي يدعو إلى الفِتنة وإلى التفلُّت وإلى الانحدار الأخلاقي، مجلسٌ لا يرضي الله، مكانٌ فيه وظيفة مُعيَّنة، لكن دائماً كل ما حولي يدعوني إلى الرشوة والفساد وأكل أموال الناس بالباطل (قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا). |
في كل زمانٍ ومكان يمكن أن يتحقَّق مفهوم الهجرة بمفهومٍ جديد:
| إذاً: في كل زمانٍ ومكان يمكن أن يتحقَّق مفهوم الهجرة بمفهومٍ جديد، وهو أن يهرب الإنسان بدينه من مكانٍ لا يُرضي الله إلى مكانٍ يُرضي الله تعالى، أن يهجر ما نهى الله تعالى عنه. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم إذاً يا دكتور السورة فصلت بين المؤمنين والمنافقين وهذا بائنٌ، وكما أسلفت وذكرت طيَّب الله أنفاسك يا دكتور، في الآية عشرين في نفس السورة قول الله تعالى: |
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ(20)(سورة التوبة)
| إذاً هذه السورة ميّزت ولم تركز على أنَّ الهجرة كانت فقط هي عبارة عن انتقالٍ مكاني، بل هي كانت مِحك للولاء، وميزان للصدق، وشاهد على صحة الإيمان، بارك الله بكم يا دكتور على هذا التوضيح الجميل، والذي نستمد منه أنوار كثيرة وخيوط كثيرة، لنتحدث عن هذه الهجرة وكيف وصفتها سورة التوبة، ولكننا نذهب إلى محورٍ آخر للآية الرابعة والعشرين يا دكتور، وهذه الآية في الحقيقة هي دستور، قول الله تعالى: |
قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(24)(سورة التوبة)
| إذاً كما ذكرت هي معيار، هي فرقٌ لمن يُحب الله ورسوله والآخرة، ولمن يُحب الدنيا وما حَوَتْ، نودّ منكم يا دكتور أن تُبيِّن لنا على ضوء هذا الكلام، كيف تتربّى الأجيال على هجرة القلب وانتماء الروح؟ |
كيف تتربّى الأجيال على هجرة القلب وانتماء الروح؟
الدكتور بلال نور الدين:
| نعم جزاكم الله خيراً، الحقيقة هذه الآية الكريمة آية مفصلية في حياة المؤمن (قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ) إلى حد هنا العائلة والعائلة الكبيرة، (وَعَشِيرَتُكُمْ) الانتماء القبائلي العشائري، (وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا) ذهبنا إلى المال والتجارة، (وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا) أكثر ما يخشى التجار من كساد البضائع، (وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا) الفلل والقصور والبيوت، إن كان كل ذلك (أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) إذاً الطريق غير سالكة إلى الله تعالى، ما دمت تجد أنَّ هناك شيئاً تُحبُّه أكثر من الله ورسوله فالطريق غير سالكة. |
| ما معنى أنه يُحب ذلك أكثر من الله؟ قد يُسأل اليوم أي مؤمنٍ في الأرض، يُقال له أتُحب الله ورسوله أكثر أم زوجتك؟ يقول: لا والله، الله ورسوله، أتُحب الله أكثر أم عشيرتك؟ يقول: لا والله، أُحِب الله، أتُحب مالُك أكثر؟ يقول: لا والله، أُحِب الله أكثر من ذلك، ليست القضية قضية أقوال، وإنما القضية قضية أفعال، أنتَ عندما تعصي الله تعالى من أجل عشيرتك، تذهب للثأر من أجل الانتقام للعشيرة والقبيلة وتترك أمر الله تعالى، فأنتَ الآن قلت بلسان حالك لا بمقالك، أنك تُحِب عشيرتك أكثر من الله، أنتَ الآن عندما تأخذ رشوةً من مالٍ مُحرَّم، أنتَ قلت المال أحبّ إليَّ من الله، أنتَ الآن عندما من أجل قصرٍ تسكنه، تبيع دينك من أجله وتُدلي بشهادةٍ كاذبة وشهادة زور، حتى تنتزع هذا القصر الذي تريده ولا تستطيع أن تتخلى عنه، أنتَ قلت بلسان حالك، أنا أُحِبُّ القصور والبيوت والمساكن أكثر من ربّي، هذه حقيقة الموضوع حتى لا نُجامل أنفسنا. |
| القضية أنَّ الأجيال كما تفضلتِ يجب أن تُربَّى على أن تهجُر المعصية وتتجه إلى الطاعة، هجرة القلب وانتماء الروح كما تفضلتِ، نحن ننتمي إلى الله، ننتمي إلى جنّة الله التي خُلقنا من أجلها، التي هي مسكننا الأساسي، والتي جئنا إلى الدنيا من أجل أن نُقدِّم عملاً صالحاً يصلح للعرض على الله، يُهيئُنا لنعود إليها أعزةً في ظلال الله تعالى وفي ظل عرشه، فبهذا المعنى يجب أن تكون محبتنا دائماً لما يُرضي الله، جاء في بعض الآثار وقد صحَّحه بعض أهل العِلم حديثاً: |
{ لا يُؤمِنُ أحدُكُم حتَّى يكونَ هواهُ تَبَعًا لما جئتُ بهِ }
(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والخطيب في تاريخ بغداد واللفظ لهما والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى)
| أي يميل القلب إلى ما يُحبه الله تعالى، أنت الآن في بداية الإيمان، قد تقول لي: قلبي يميل إلى المعصية ولكنني أتركها خوفاً من الله، جميل جداً بوركت، لكن بعد حينٍ ستقول لي: أنا أترك المعصية لأنني أكرهها، لأنَّ فيها فساداً لقلبي وفساداً لأسرتي، لأنَّ ما حرَّمه الله هو شيءٌ خبيث ولأنَّ ما أحلَّه الله هو الطيِّب، هُنا الإيمان يكون في مرتبةٍ أعلى، عندما يجد الإنسان هوى نفسه بطاعة الله، يُسرّ عندما يقف بين يدي الله. |
| كان ثابت البناني وهو أحد التابعين يقول: "تعذبت بالصلاة عشرين سنة، ثم تنعّمت بها عشرين سنةً أُخرى، والله إني لأدخل فيها وأنا أحمل همّ خروجي منها"، أي عشرين سنة وهو يضغط على نفسه في كل صلاةٍ، يريد أن يُصلّي ونفسه تنازعه أن يترك الصلاة، ثم عشرين سنةً يتنعَّم بها، فإذا قال: "الله أكبر" همُّه أنها ستنتهي، يعني منزعج لأنَّ الصلاة ستنتهي، فانتقل من حال أرِحنا منها إلى حال أرِحنا بها، فهذا معنى: (إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ) المعنى أنَّ الإنسان يجب أن يُربّي نفسه ويُربّي أولاده ويُربّي طلابه ومن حوله، على أنَّ طاعة الله تعالى فوق كل اعتبار وفوق كل شيء، والهجرة تُعلِّم هذا الموقف المُهم، الصحابة الكرام كانوا في مكَّة بلادهم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكَّة بكى، قال: |
{ عن ابنِ عباسٍ، قال: لما خرجَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم من مكةَ قال: أمَا واللهِ إني لأَخرجُ منكِ وإني لأعلمُ أنك أحبّ بلادِ اللهِ إلى اللهِ، وأكرمهُ على اللهِ، ولولا أهلكِ أخرجُوني منك ما خَرجتُ }
(أخرجه الترمذي وابن حبان والطبراني)
| ما الذي دفعه لأن يترك موطن صباه؟ لمّا ذَكَّرهُ أُصَيل وذَكَر له الربيع في مكَّة وكيف هو الربيع في مكَّة، النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لها، قال: "لا تُشوّقنا يا أُصَيل"، كُفّ عن الكلام اشتاقت القلوب، لكن لماذا فعل؟ فعل إرضاءً لله تعالى، تركاً لما تُحبه نفسه وإرضاءً لما يُحبه مولاه. |
{ ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه مِمَّا سِواهُما، وأنْ يُحِبَّ المرْءَ لا يُحبُّهُ إلَّا للهِ، وأنْ يَكْرَهَ أنْ يَعودَ في الكُفرِ بعدَ إذْ أنقذَهُ اللهُ مِنْهُ؛ كَما يَكرَهُ أنْ يُلْقى في النارِ }
(أخرجه البخاري ومسلم والترمذي)
حقائق الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيءٌ آخر:
| حقائق الإيمان شيءٌ سهل، الآن أي مؤمن قُل له ما أركان الإيمان؟ يُعددها أو معظم المؤمنين لكن هذه حقائق، أمّا حلاوة الإيمان فشيءٌ في داخل النفس يدفع الإنسان إلى أن يترك كل شيءٍ في سبيل أن يحافظ على تلك الحلاوة، حقائق الإيمان تشبه أن تنظر على هاتفك إلى إعلانٍ رائعٍ جداً لسيارةٍ فارهة، من أحدث طرازٍ ومن أفضل ماركة، هذه حقائق، الحلاوة أن تركب في هذه السيارة وتقودها وتُصبح مُلكاً لك، كم هو الفرق بين الأمرين؟ في الدنيا طبعاً، كذلك هو الفرق بين أن تقول الله وأن تعيش مع الله، أن تقول أُحِب الله وأن تُضحّي في سبيل الله، أن تقول أُحِب رسول الله وأن تدمع عينك نُصرةً لرسول الله ومحبةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقٌ كبير، ما الثمن الذي تدفعه من أجل حلاوة الإيمان؟ قال: (أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إليه مِمَّا سِواهُما) وهذا ما أكَّدته الآية الكريمة التي كنّا بصدد الحديث عنها. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم، إذاً من هذا المحور يا دكتور نتحدث عن المؤاخاة، فماذا تُحدثنا يا دكتور وهي كانت النموذج للسلم المُجتمعي، وأنها كانت وثيقةٌ على الدين وليس وثيقةٌ على الدم، فهل كانت هذه المؤاخاة حلَّاً نبوياً لأزمة الهوية والانتماء، وكيف نفهما اليوم؟ |
الدكتور بلال نور الدين:
| بارك الله بكم، الحقيقة ربنا جلَّ جلاله قال: |
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(9)(سورة الحشر)
علاقة المؤاخاة بالهجرة:
| قضية المؤاخاة كما تفضَّلتم لها علاقةٌ بالهجرة، والحقيقة كما تفضَّلتم هي وثيقةٌ على الدين، مؤاخاة من نوعٍ آخر، مؤاخاة من نوع قوله تعالى: |
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(10)(سورة الحجرات)
| (إِنَّمَا) أداة حصرٍ وقصر. |
المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ ، و المؤمنُ أخو المؤمنِ ، يكفِ عليه ضيعتَه ، و يحوطُه من ورائِه(أخرجه أبو داوود والبزار والطبراني)
| لا تُفرِّقهم الحدود، ولا تُباعد بينهم الصحارى، فالناس جميعاً يلتقون على شيء، أحياناً يلتقي الناس على مواطن الماء، هذا المكان فيه ماء يتجمَّع الناس فيه، بلد أصبحت فيه تجارة رائجة فيه فُرص استثمارية كبيرة، فيتجمَّع الناس من أجلها، أحياناً من أجل الأسرة، يقول لك عائلتي في هذا المكان، فالناس يتجمعون. |
نحن تجمعنا أُخوُّة الدين وأُخوُّة الانتماء إلى العقيدة الصافية:
| لكن هذه التجمعات أحياناً قد تُشبه وأنا آسف لهذا التعبير تجمعات كائناتٍ أُخرى، أحياناً القطيع يتجمَّع من أجل الماء، لكن نحن لا نتجمَّع من أجل الكلأ والماء، صحيحٌ أنَّ هذا مطلبٌ في الإنسان لكن نحن نتجمَّع لأهدافٍ أسمى، أهداف أعلى بكثيرٍ من قضية طعامٍ وشراب، نحن تجمعنا أُخوُّة الدين، تجمعنا أُخوُّة الانتماء إلى هذا الدين العظيم، أُخوُّة الانتماء إلى العقيدة الصافية، فنحن إذ نتجمَّع نتجمَّع لنُصرة ديننا، ولنُصرة الحق وأهل الحق، حتى لو نصرنا غير المسلم، فإننا ننصره بالحق، فنحن ننصُر المسلم وغير المسلم على الحق، فتجمعنا العقيدة. |
| فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر إلى المدينة، كان أول عملٍ قام به أنه بنى المسجد، العمل رقم اثنان آخى بين المهاجرين والأنصار، أُخوُّةً حقيقة أُخوُّةً مُستمدَّةً من الإيمان، حتى أصبح المهاجر أخاً للأنصاري أكثر من أخيه النَسَبي، لأنه ربما يجتمع معه أحياناً على أشياءٍ لا يجتمع فيها مع أخيه النَسَبي، كان هناك مؤمنٌ وأخوه لم يؤمن بعد، فاجتمعوا على الإيمان، واجتمعوا على أُخوُّة العقيدة، وعلى أُخوُّة الدين، فكانت أكبر من أُخوُّةِ النَسَب وأُخوُّةِ الدم، وما أحوجنا اليوم في عصرنا هذا إلى هذا المعنى. |
| الحقيقة الأردن بأهله وبطيبة أهله، وأنا لا أقول ذلك لأنني على الإذاعة الأردنية، وإنما لأنني أتلمّس ذلك حقيقةً، هذا البلد دائماً كان يؤوي من حصلت معهم مشكلات في بلادهم فأووا إليه، دائماً الأردن تجد فيه الأخ من البلد الفلاني والفلاني يجتمعون معاً في هذا البلد، تجد الناس يتقبلونهم بصدرٍ رحب |
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(9)(سورة الحشر)
| رغم موارده القليلة أحياناً، رغم الصعوبات التي يُعانيها أهله، لكن يستقبل الوافدين من شتَّى البلدان، وهذه ميّزة تُذكَر لهذا البلد الطيِّب، ففي تطبيقات المؤاخاة الحقيقية، اليوم يوجد حروب في العالم، أهلنا في فلسطين يُعانون ما يُعانون، أهلنا في بلدانٍ كثيرة يُعانون، سابقاً ونسأل الله أن لا يكون لاحقاً، فأن نتآخى في الله، نحن لا تُفرقنا حدود سايكس بيكو، هذه حدودٌ رُسمت على الطاولة، لكن نحن إخوةٌ جميعاً، ضمَّنا الإسلام إخواناً جميعاً، فنجتمع على العقيدة، على الولاء للدين، على الولاء للحق ولأهل الحق. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم، وأتوقف قليلاً يا دكتور عند درسٍ عظيمٍ، وأنا أعود إلى محورٍ في بداية الحلقة ناقشناها معك، وهي أنَّ الهجرة ليست رحلة تاريخ، بل هي معيار صدقٍ وبناءٍ وعدل، لكن سؤالي هُنا يا دكتور، أنه في كل زمانٍ يكون هناك من يُضحّي، من يتخلَّف، ومن يُنصِف دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ما تعليقكم يا دكتور؟ وبماذا تدعوننا والمستمعين بارك الله بكم؟ |
الهجرة حركة مدروسة واعية لتغيير الواقع:
الدكتور بلال نور الدين:
| حيّاكم الله، الحقيقة كما تفضَّلتم الهجرة هي حركة، وهذا ما بدأنا به، وأنا أُعرِّف الهجرة دائماً بأنها حركة مدروسة واعية لتغيير الواقع، وأقول مدروسة وواعية لأنه أحياناً التغيير من غير دراسةٍ ووعيٍ قد يؤدّي إلى نتائجٍ كارثية، ودونكم تجارب في بلدانٍ كثيرة، رغب الناس فيها بالتغيير، وربما أحياناً بصدق نية، لكن كانت النتائج كارثيةً، فالتغيير دائماً ينبغي أن يكون مدروساً وواقعياً وواعياً ووفق الضوابط الشرعية، حتى يكون الانتقال إلى الأفضل ولا يكون الانتقال إلى الأسوأ. |
| الإنسان بتجارته اليوم، إذا إنسان مدير شركة وعنده موظفون، قد يجد من المناسب أن يصرِف موظفاً من الموظفين، لكن دون أن يدرس الواقع الموجود، فيصرفه ثم يكتشف أنه بحاجته، وأنه يحمل ملفات مهمة جداً، وهو تخلَّى عنه في وقت، فيُقال غيَّرت، أنا أُريد أن أُغيِّر، لكن غيَّرت نحو الأسوأ، ضررت بالشركة التي أنت فيها، هذه في علم التجارة. |
النبي رتَّب رحلة هجرته وتوكل على الله وهيأ المجتمع الجديد لتقبُّل الفكرة:
| النبي صلى الله عليه وسلم يوم أراد أن يُغيِّر وأن يهاجر، اتخذَ ترتيباتٍ عظيمة في هجرته، هيأ المدينة لاستقبال الواقع الجديد، أرسل مصعب بن عُمير رضي الله عنه، مُقرئ المدينة وسفير الإسلام، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، كان يُهيئ المجتمع في المدينة لاستقبال الدعوة الجديدة، ما ذهب هكذا، ثم هيأ الرحلة، ترتيبات الرحلة كلها كانت ترتيبات مُنظَّمة مُنسَّقة، بدأً للسرّية لم يُعلِم إلا أبا بكر رضي الله عنه وأهل بيته، من يمحو الآثار الخبير عبد الله بن أُريقط، نزل مساحلاً إلى الجنوب لم يخرُج بالطريق المُعتاد، خرج من الباب الخلفي، خرج قُبيل الفجر في الظلام، ترك سيدنا علي رضي الله عنه في فراشه، ترتيبات الرحلة كلها كانت ترتيبات فيها اتخاذ للأسباب، ثم ظهر توكله على ربّ الأرباب، يوم قال وهو في غار ثور: |
إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(40)(سورة التوبة)
| فرتَّب الرحلة وتوكل على الله، وهيأ المجتمع الجديد لتقبُّل الفكرة. |
| الآن عندما نريد أن نُغيِّر ينبغي أن نأخذ بسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اليوم نقول سندخل إن شاء الله عام ألفٍ وأربعمئة وسبعٍ وأربعين، وثمانٍ وأربعين، وتسع وأربعين للهجرة وهكذا، لماذا؟ لأنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه وجد أنَّ خير ما يُبدأ به بعد أن استشار الصحب الكرام، أن يُبدأ التأريخ بالهجرة، لأنَّ الهجرة حركة، أمّا لو بدأهُ بالإسراء والمعراج، لقال أحدنا هذه معجزة، لو بدأهُ بالبعثة النبوية لقال قائلٌ: البعثة هذا تقديرٌ من الله عزَّ وجل، ليس فيها جهداً بشرياً أبداً، كلها واضحة، من مولد النبي صلى الله عليه وسلم الله اختار هذا اليوم لمولده، كلها أحداثٌ مهمة، لكن ما الحدث الذي فيه سُنَن كونية، فيه تغيير وفق السُنَن الكونية، فيه تغيير وفق ما أراده الله تعالى منّا هو حدث الهجرة. |
كل حدَث يظهَر إلى الساحة يُبتلى الناس به والحدث الأخير لأهلنا في غزة:
| لذلك اليوم هذا الموقف الناس يأخذون منه مواقف مُتباينة، هناك من يُضحّي متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يتخلَّف عن الركب، وهناك من يكون من السبَّاقين، وهناك من يكون من المُتخاذلين، هذه هي سُنَّة الحياة، هي ابتلاء كما كانت الهجرة ابتلاءً، فنحن نعيش هذا الابتلاء، أي الامتحان وليس بالمعنى السلبي، الابتلاء بمعنى الامتحان، نعيشه إلى اليوم، إلى يومنا هذا نعيش معاني الابتلاء والامتحان، فكل حدَث يظهَر إلى الساحة يُبتلى الناس به، الحدث الأخير لأهلنا في فلسطين في غزَّة الطيَّبة، ابتلاءٌ عظيمٌ من الله، كل إنسان وقف موقفاً، هناك من وقف مع الحق وأهل الحق، وهناك من تخاذل، وهناك من دعم وقدَّم ما يستطيعه، وهناك من تخلَّف وتراجع، هذه هي سُنَّة الحياة. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| نعم بارك الله بكم، وفي ختام هذه الحلقة وختام مَحاورنا يا دكتور، نظرة سورة التوبة إلى التقصير في الهجرة والنفقة، الله تعالى يقول: |
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ(7)(سورة المنافقين)
| إذاً تُظهِر السورة أنَّ حتى النفقة على المهاجرين كان فيها مِحنةٌ للقلب، كيف نربط ذلك بالواقع العصري في نصر أهل الدعوة؟ |
ربط النبي بين الإيمان وهو الجانب العقدي وبين الهجرة وهي الجانب الحركي السلوكي:
الدكتور بلال نور الدين:
| الحقيقة أنه في سورة التوبة أيضاً قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) فربَطَ النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وهو الجانب العقدي، والهجرة وهي الجانب الحركي السلوكي الناتج عن التصورات الإيمانية، ثم قال: (وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) جزءٌ من الحركة، جزءٌ مهم هو الجهاد، أي استنفاذ الوسع والجهد في طلب شيءٍ ما، هذا الجهاد قدَّم فيه المال على النفس، قال: (بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ) المال مُحبَّب إلى النفس، والمال كما يقول العوام شقيق الروح، والله تعالى في القرآن في معظم الآيات يُقدِّم الجهاد بالمال على النفس، لأنه لا يمكن أن يتحقَّق جهادٌ بالنفس إن لم يكن هناك إعداد، أهمية النفقة في سبيل الله كجزءٍ من تهيئة الدُعاة وتهيئة المُجاهدين ونُصرة الحق وأهل الحق، فقال: (وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ). |
| ثم أيضاً قال تعالى: |
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(10)(سورة الحديد)
| بمعنى أنَّ من ينفق ماله في لحظات الشدّة والعُسرة والضيق، والإسلام مُحاصَر، والمسلمون ضُعفاء، وكل شيءٍ حوله يدعوه لترك الإنفاق، ثم هو ينفق في سبيل الله، هذا أعظم درجةً من الذي ينفق وهو في حالة اليسر والرخاء، فمَن أنفق قبل الفتح ليس كمَن أنفق بعد الفتح، بعد فتح مكَّة رخاء واستقرار فدفع من ماله، لكن من أنفق قبل الفتح، أنفق في لحظات الشدّة والعُسرة والضيق، هذا أعظم درجةً عند الله تعالى، والله تعالى لم يعذُر أحداً من ترك الجهاد والنفقة والهجرة، قال: |
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا(98)(سورة النساء)
| غير القادر فقط، أمّا القادر على النفقة يجب أن ينفق، القادر على الجهاد بماله يجب أن يجاهد بماله، والقادر على الجهاد بعلمه وبدعوته يجب أن يجاهد بعلمه ودعوته، والقادر على الإنفاق يجب أن ينفق إلى غير ذلك. |
المُحاوِرة هناء المجالي:
| بارك الله بكم يا دكتور، إذاً الهجرة ليست فقط حدثٌ في التاريخ نحتفل به في بداية كل سنةٍ هجرية، بل معيارٌ لبناء المجتمع المُتماسك، ودليلٌ على أنَّ الرسالة التي بدأت في الغار لم تكن لعبادةٍ فردية، بل لبناء عالَمٍ مُستخلَف، يسكنه السلام والعدل والرحمة، بارك الله بكم فضيلة الدكتور بلال نور الدين، ونفع الله بكم، وزادكم من علمه ومن فضله، جُزيتم خير الجزاء يا دكتور. |
الدكتور بلال نور الدين:
| وإيّاكم بارك الله بكم، وشكراً لهذه الاستضافة. |